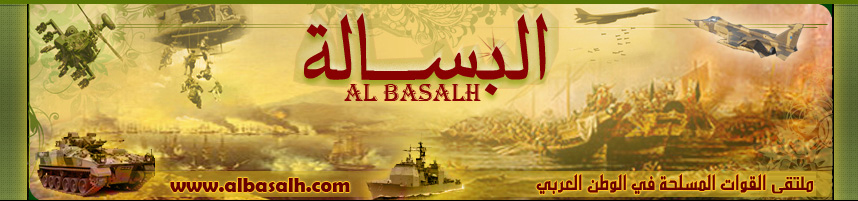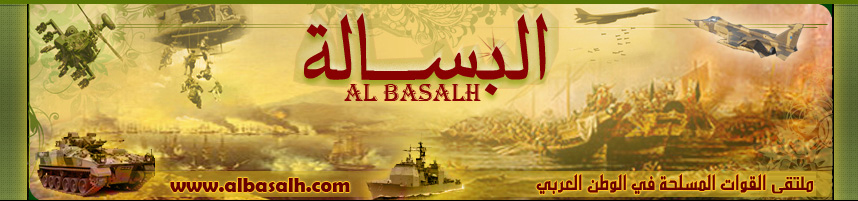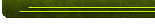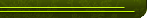لذلك فإن القائلين بثبوت القصة لا يستندون فقط إلى ابن الكردبوس وابن هذيل ورواية المقري أو ابن عذاري، بل يحاولون تعزيزها بقرائن من أحداث مشابهة في تجارب قادة آخرين عبر العصور، مما يمنح القصة إطارا من المعقولية التاريخية حتى وإن بقيت مثار جدل.
ولكن في مقابل الأصوات التي تميل إلى إثبات حادثة إحراق السفن، يقدّم فريق من المؤرخين والباحثين جملة من الاعتراضات المنهجية التي تُضعف من صدقية القصة وتجعلها أقرب إلى الأدب الرمزي منها إلى الحدث التاريخي.
وأول هذه الاعتراضات يرتبط بالمنطق العسكري، فليس من المتصور أن يُقْدِمَ قائد مثل طارق بن زياد على تدمير وسيلة النجاة الوحيدة لجيشه وهو على أرض مجهولة المصير، يواجه فيها قوة عظمى كالجيش القوطي، فالتصرف في هذه الحالة يعادل الانتحار الجماعي أكثر منه خطة حربية مدروسة.
ثم إن الروايات نفسها تخبرنا أن طارق بعث إلى قائده الأعلى موسى بن نصير طالبا المدد حين واجه جيوش القوط، فمدّه موسى بخمسة آلاف مقاتل إضافي، وهنا يبرز التساؤل: كيف تمكّن موسى من إرسال هذه الأعداد الكبيرة عبر البحر إذا كانت السفن قد أُحرقت بالفعل؟ هذا الطرح يقود بدوره إلى إشكالية أخرى تتعلق بالقدرة اللوجستية، فهل كان بوسع الترسانات البحرية الإسلامية في تلك الحقبة أن تصنع في فترة وجيزة أسطولا جديدا لنقل الآلاف من الجنود؟ الأمر يبدو بعيدا عن المعقولية التاريخية.
ويضيف بعض المشككين بُعدا آخر للنقد، فحتى لو افترضنا أن السفن كانت تعود لحاكم سبتة يليان، فبأي حقّ يُقْدِم طارق على إحراقها؟ أليست ملكية الرجل الخاصة جزءا من اتفاقه مع الجيش الإسلامي؟ بل كيف يتصرّف طارق أصلا في موارد الدولة دون إذن الخليفة الأموي الذي تعود له الكلمة الفصل؟ من هنا يرى هؤلاء أن الخطبة المنسوبة وما فيها من مشهد إحراق السفن إنما تعكس صورة بلاغية لبثّ الحماسة في الجنود أكثر مما تعكس واقعة حقيقية.
وفي هذا السياق يشير المؤرخ محمود علي مكي في دراسة له بعنوان "أسطورة إحراق السفن في التاريخ" إلى أن من بين النماذج التي تغذي المخيلة التاريخية في الشرق هذه الأسطورة التي ارتبطت بالقائد الفارسي وهرز حين عبر إلى اليمن لمساندة سيف بن ذي يزن في طرد الأحباش، فقد نُسب إليه أنه أحرق سفنه بعد نزول جيشه إلى البر، وألقى في جنوده خطبة حماسية شحذ بها عزائمهم، وهي صورة خطابية ستجد صداها لاحقا في روايات بعض المؤرخين عن فتح الأندلس.
ويرى مكي أن قصة إحراق وهرز لمراكبه، مقرونةً بخطبة تحثّ على الصمود، تُمثِّل الجذور الأولى لأسطورة إحراق السفن المنسوبة إلى طارق بن زياد، بوصفها رمزا للتضحية والفداء، وهي منذ ذلك الحين صارت مثالا مفضّلا عند رواة أخبار الغزوات البحرية، حيث يواجه جيش صغير خصما يفوقه عددا وعدة.
ومن هذه الأرضية الأسطورية ينتقل مكي للحديث عن وقائع فتح الأندلس نفسها، مميزا بين ما هو متخيّل أدبي وما هو ثابت تاريخيا، فالمصادر المتفقة على تفاصيل العبور ومعركة شذونة (وادي لِكة) تشير بوضوح إلى حقيقة الفارق الشاسع بين جيش المسلمين وجيش القوط، وإلى أن المواجهة انتهت يوم 28 رمضان سنة 92هـ بانتصار حاسم للمسلمين الأقل عددا، دون حاجة إلى إقحام مشهد إحراق السفن في السرد، وهكذا يوضح مكي أن الفتح الأندلسي كان قائما على معطيات عسكرية حقيقية، بينما جرى استدعاء الأسطورة الشرقية لإغناء القصة ومنحها بُعدا بطوليا دراميا.
تذهب الغالبية الساحقة من الباحثين الإسبان اليوم إلى أن قصة إحراق طارق بن زياد للسفن لا تعدو كونها خبرا أدبيا أسطوريا أُضيف لاحقا إلى روايات الفتح، وليست واقعة تاريخية تثبتها المصادر الأولى، وحجتهم الرئيسة في ذلك أن أقدم النصوص مثل "الكرونيكا الموزاربية" لعام 754، وهي أقدم شاهد لاتيني كُتب بعد أحداث الفتح بأربعين سنة، وكذلك المصادر العربية المبكرة عند البلاذري وابن عبد الحكم وغيرهم لم تذكر شيئا عن الإحراق، بل اكتفت بذكر دور يوليان حاكم سبتة في تسهيل العبور.
هذه النتيجة يؤكدها الباحث أليخاندرو غارسيا سانخوان في دراسته "أسباب الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية"، حيث يوضح أن مشاهد الخطبة والمعجزة والإحراق تنتمي إلى طبقة روائية متأخرة لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على وقوع الحدث.
وبالمنهج نفسه يقدّم إدواردو مانثانو مورينو، الباحث في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد، قراءة نقدية في بحثه "المصادر العربية حول فتح الأندلس: قراءة جديدة"، حيث يؤكد فيه أن روايات الفتح الأندلسي في المصادر الأندلسية والمشرقية المتأخرة امتلأت بالتوسعات الأدبية والتقاليد البلاغية، ومن بينها قصة الإحراق، وهو ما يُوجب على المؤرخ تغليب الروايات الأقدم زمنا وتجنّب رفع هذه الأخبار الدرامية إلى مرتبة الحقيقة التاريخية.
أما الباحثة أومايرا إيرّيرو سوتو، فقد خصّصت دراسة بعنوان "خطبة طارق بن زياد: مثال على الصياغة البلاغية في التأريخ العربي"، لتبيّن فيها أن مشهد حرق السفن ليس سوى "توبوس بلاغي" أو مجرد ثيمة متكررة في أدبيات الغزو عند ثقافات مختلفة، إذ يُستخدم لإيصال فكرة "عدم الرجوع"، بهدف رفع معنويات الجنود أكثر من كونه وصفا واقعيا.
وفي دراسة لاحقة للباحثة نفسها بعنوان "طارق بن زياد: الرؤى المختلفة لقائد بربري في المصادر الوسيطة" تؤكد أن حضور قصة الإحراق في المصادر محدود للغاية، لكنه ترسخ في الذاكرة الأدبية اللاحقة بوصفه رمزا بطوليا.
ويضيف لويس مولينا في مقاله "رواية عن فتح الأندلس" أن كتاب "أخبار مجموعة" الذي جُمِّع في
قرطبة بالقرن الحادي عشر هو النص العربي الوحيد الذي يورد بصراحة عبارة الإحراق تلك، ويخلص مولينا إلى أن هذه التفاصيل الدرامية لا يجوز التعامل معها بوصفها خبرا أصيلا؛ لأنها تنتمي إلى طبقة روائية متأخرة اعتمدت على مواد أقدم لكنها أضافت إليها عناصر تخييلية.
وهكذا يتفق أغلب الباحثين والمؤرخين العرب والإسبان المعاصرين على رفض قصة إحراق السفن لأسباب تاريخية وعقلانية، كان على رأسها ضرورة وصول الرسائل والمدد إلى الفاتحين الجدد من القيادة العليا في شمال
أفريقيا التي كان يقودها موسى بن نصير وقتئذ، وعدم وجود ترسانة إسلامية قادرة على صنع سفن أخرى بديلة لاستكمال عملية الفتح التي بدأت في رمضان سنة 92هـ.