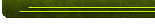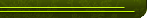تحالف الإخوة الأعداء.. التاريخ الطويل للخلافات بين روسيا والصين
 The Atlantic
كان الرئيس الصيني "شي جينبينغ"، قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، يفكر مليا على الأرجح في منافع علاقته الحميمية بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". وقتها انصبَّ تركيز نظيره الروسي على كبح جماح القوة الأميركية، مُوتِّرا بذلك الحلفاء الأميركيين في أوروبا، ومسبِّبا التوتر لديمقراطية شابة مجاورة له في كييف، وهي أمور لم تكلِّف الصين شيئا في الغالب. ولعل بوتين كان سيمهِّد السبيل للرئيس الصيني لتحقيق غايته الأسمى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية: ألا وهي المطالبة بتايوان.
The Atlantic
كان الرئيس الصيني "شي جينبينغ"، قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، يفكر مليا على الأرجح في منافع علاقته الحميمية بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين". وقتها انصبَّ تركيز نظيره الروسي على كبح جماح القوة الأميركية، مُوتِّرا بذلك الحلفاء الأميركيين في أوروبا، ومسبِّبا التوتر لديمقراطية شابة مجاورة له في كييف، وهي أمور لم تكلِّف الصين شيئا في الغالب. ولعل بوتين كان سيمهِّد السبيل للرئيس الصيني لتحقيق غايته الأسمى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية: ألا وهي المطالبة بتايوان.
بيد أن مخاطر شراكة الصين مع روسيا بدت جلية للعيان منذ أن دقت الحرب طبولها، وفرضت شبكة تحالفات أميركية بصورة جماعية عقوبات تدميرية على روسيا. وما حاولت بكين أن تقوم به هو ما تفعله دائما، أي اللعب على جميع الجوانب وادعاء الحياد، غير أنها وجدت نفسها ناشزة عن القوى العظمى في العالم. لكن تناقضات الصين لا ينبغي أن تثير الدهشة، فحتى منذ الأيام الخوالي للحزب الشيوعي قبل قرن، كانت علاقة بكين مع موسكو حبلى بالوعود، ومُعرّضة للخطر في الوقت ذاته، تماما كما هو حالها اليوم.
إن التحسُّن في العلاقات الصينية-الروسية ما انفك يقلق الخبراء الأمنيين في واشنطن من أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى التنافس مع حلف آثم لدولتين من أكثر الدول السلطوية القوية في العالم، والمصمِّمتين على إعادة تشكيل النظام العالمي لصالحهما. وربما تمثل عصبتهما معا تحديا إستراتيجيا كبيرا؛ فمواجهة خصم تلو الآخر أمر شاق بما يكفي، ولكن كما يظهر اجتياح بوتين لأوكرانيا بصورة مأساوية، فإن الانقضاض المزدوج والمُنسَّق نوعا ما على القوة العالمية الأميركية لربما يكون أكثر تعقيدا. قد تساعد بكين وموسكو بعضهما بعضا على التملص من العقوبات الأميركية، ومن ثَمّ تجريد واشنطن من نفوذها، فالاحتمالات المناوئة لأميركا هنا لا نهاية لها ولا حصر.
لكن تحالف الصينيين والروس لم يكن قطّ قاعدة مفروغا منها، فقد ضيعت الصين وروسيا فرصتهما للاتحاد معا ضد الولايات المتحدة في الحرب الباردة، حيث أودت بهما الصراعات الأيديولوجية والتنافس الشخصي إلى تدمير ذاتي. واليوم أيضا لا تتحاذى المصالح الروسية والمصالح الصينية، بل من المرجح للغاية في واقع الحال أن كلتيهما في طريقهما إلى مستقبل مختلف عن الأخرى.
الأنكى أن علاقات الصين مع روسيا غدت حالة اختبار لماهية الدور الذي يريد قادة بكين أن يلعبوه في العالم، فهُم يدَّعون دائما أنهم يفضِّلون "التعايش السلمي"، وأنهم يريدون وضع حد لـ"عقلية الحرب الباردة" المسببة للنزاعات والشقاقات، بيد أن الانحياز لبوتين -ولو ضمنيا- في مسعاه البائد والمحفوف بالمفارقات التاريخية لإعادة خلق الإمبراطورية السوفيتية، يجعل الرئيس الصيني وكأنه ليس سوى ديكتاتور آخر قيد التشكل. إن المسألة اليوم هي كيف تدير بكين علاقتها بموسكو، وهو أمر سيساعدها بالتبعية في تعريف وضعها بوصفها قوة عظمى.
الصين بين واشنطن وموسكو
لقد حُدِّدت مكانة الصين في العالم في العقود الأخيرة إلى حد كبير من خلال علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلا أن روسيا تُعد، في كثير من النواحي، حاسمة بدورها في مسار الصين الحديثة، بخير ذلك وشرِّه على السواء. كانت العلاقات بين النظامين الشيوعيَّين مشؤومة منذ بدايتها، تحديدا مذ استقلّ "ماو زيدونغ" في ديسمبر 1949 -أي بعد أن أسس الجمهورية الشعبية التي أعقبت الحرب الأهلية الصينية بشهرين فحسب- عربةَ قطارٍ مُدرّعة للالتقاء بجوزيف ستالين في روسيا. وقد وصل "ماو" طالبا العون، متوسِّلا مُعدما أمام المِعطاء الذي لا يضاهى للعالم الشيوعي، إذ كان القائد الصيني سليل دولةٍ مزقها الفقر ونهشتها الحرب واجتاحها عَوَزٌ بالِغٌ إلى المال والتكنولوجيا والدعم الدولي، وكانت الدولة الروسية محورية في نجاة نظامه.
 جوزيف ستالين وماو زيدونغحين اجتمع القائدان، وجَّه ماو أسئلته إلى ستالين عن كل شيء تقريبا، بدءا من إبرام معاهدة تحالف، إلى طلب مساعدة مادية وأخرى عسكرية وحتى المساعدة في تحرير كتاباته. كان ستالين مُشجعا، لكنه غير واضح، حيث نزل ماو في بيت ريفي خارج موسكو، حيث استمرت المساومة القاسية لأسابيع. وتحصَّل ماو في نهاية المطاف على ميثاق صداقة وُقِّع في فبراير 1950، لكنه حصل عليه بشروط مُذلّةٍ استدعت -فيما استدعت- ذكرى "المعاهدات المجحفة" التي فرضتها القوى الإمبريالية على الصين في القرن التاسع عشر.
جوزيف ستالين وماو زيدونغحين اجتمع القائدان، وجَّه ماو أسئلته إلى ستالين عن كل شيء تقريبا، بدءا من إبرام معاهدة تحالف، إلى طلب مساعدة مادية وأخرى عسكرية وحتى المساعدة في تحرير كتاباته. كان ستالين مُشجعا، لكنه غير واضح، حيث نزل ماو في بيت ريفي خارج موسكو، حيث استمرت المساومة القاسية لأسابيع. وتحصَّل ماو في نهاية المطاف على ميثاق صداقة وُقِّع في فبراير 1950، لكنه حصل عليه بشروط مُذلّةٍ استدعت -فيما استدعت- ذكرى "المعاهدات المجحفة" التي فرضتها القوى الإمبريالية على الصين في القرن التاسع عشر.
إلا أن الروس قدموا كمّا هائلا من المساعدات، "وهي مساعدات أكبر من أي برنامج مثيل قامت به أي دولة في أي مكان آخر، بما في ذلك خطة مارشال الأميركية من أجل أوروبا" على حد تعبير المؤرخ "أود أرني وِستَد" في كتابه "الحرب الباردة: تاريخ عالمي". فقد درَّب المستشارون السوفييت ضباط الجيش الصيني، ومدوا يد المساعدة في تخطيط المدن الصينية. وازدادت حمية موسكو بعد موت ستالين، فقد آمن "نيكيتا خروشوف"، وريث الديكتاتور الروسي، بأن الصين هي مفتاح الانتصار المطلق للشيوعية على الغرب.
بيد أن العلاقات بين القوتين أخذت تتفكك في أواخر الخمسينيات، وغدا ماو مستاءً من وضعه بوصفه تابِعا في الهرمية الشيوعية، وانفصل عن موسكو على مستوى السياسات الاقتصادية والخارجية. فبالنسبة إلى ماو، كان السوفييت يعانون من "التفكير اليميني". وأوشكت المناوشات الحدودية بين البلدين عام 1969 أن تصل إلى حرب شاملة بينهما. وقد هدَّد حينها الروس باستخدام الأسلحة النووية، وخشي ماو من أن يقوموا بذلك حقا. وانقشعت التوترات عبر المفاوضات، بيد أن التنازع الشديد بين موسكو وبكين دفع ماو إلى اتخاذ قرار غيَّر مجرى التاريخ: ألا وهو اجتماعه بالرئيس الأميركي "ريتشارد نيكسون" عام 1972، والتصالح مع الجلَّاد الإمبريالي المفترض للصين.

ماو زيدونغ وريتشارد نيكسونأمَّا في السنوات الأخيرة، فقد انقلب التاريخ رأسا على عقب مجددا، إذ ترسَّخت أواصر العلاقات الصينية-الروسية بالتزامن مع تزايد التوترات بين بكين وواشنطن. وقد أشار الرئيس "شي" إلى بوتين بوصفه "أفضل أصدقائه"، وأكَّد الرجلان بعد اجتماعهما الأخير في فبراير قبل دورة الألعاب الأولمبية في بكين على أن الصداقة بين الدولتين "لا حد لها". وهناك بالفعل الكثير من العوامل التي تقرِّب البلدين، على سبيل المثال، تُكمِّل الدولتان بعضهما بعضا اقتصاديا، كما تُعَد روسيا مورِّدا لمواد خام ذات أهمية شديدة للصين، بينما تحتاج روسيا من الصين الاستثمار والمنتجات عالية الجودة تقنيا. هذا ونمت التجارة بينهما بنسبة 36% في العام الفائت فقط، حيث وصلت إلى 146 مليار دولار، واتحدتا في مشاريع مثل تطوير طائرة تجارية لمنافسة شركتَي بوينج وإيرباص.
إلا أن "معاداة أميركا" تظل هي المكوِّن السري في تلك الصداقة الجديدة كما أخبرني الزميل البارز في مركز كارنيغي بموسكو "ألكسندر جابويف"، حيث يتشارك كلٌّ من بوتين وشي هدفا مشتركا في إبعاد النفوذ الأميركي عن حدودهما، وحلِّ عُرى التحالفات الأميركية التي تقع في جوارهما. يقلق بوتين من زحف الناتو، خطوة تلو الخطوة، بمقربة من روسيا، ويصر شي أيضا على أنه محاصر بشبكة من الشركاء الأميركيين في جميع أرجاء آسيا. وهكذا، في هذا المسعى نحو إعادة تشكيل الخارطة الجيو-إستراتيجية العالمية، فإن الجهد المشترك المبذول من أجل زيادة الضغط على الولايات المتحدة الأميركية في أوروبا وآسيا قد يكبح مساعي واشنطن، ويشيع الشك بشأن الالتزامات الأميركية العالمية. وكلّما استطاعت الدولتان أن تتاجرا وتستثمرا مع بعضهما بعضا، صارتا أقل تعرُّضا للعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة. وإذا استخدمتا عملتيهما الوطنيتين في تلك الأعمال التجارية، فقد تتخلّصان من أَسْر الدولار الجبار. بيد أنه رغم ذلك، ليست هناك سوى حفنة قليلة من الأسباب للشك بأن شيئا من هذا قد يحدث.
عوامل التنافر بين روسيا والصين
الأنكى والأهم من ذلك هو أن البلدين يسيران في اتجاهين معاكسَين. إذ يتربع بوتين على عرش سلطة متآكلة تفتقر إلى الحيوية الاقتصادية اللازمة للإبقاء على نفوذها السياسي، ومن ثَمّ يمكنه أن يحمل على عاتقه مهمة رمي قذيفة على النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. على النقيض من ذلك، تنظر الصين إلى نفسها بوصفها قوة صاعدة، وأن صعودها هذا يظل مرهونا (حتى الآن على الأقل) بالنظام العالمي نفسه. ويرغب شي، مثله مثل بوتين، في أن يقلب النظام، ولكن ليس بوسعه أن يتحمل الاضطرابات أكثر من اللازم، كما أن الاقتصاد الصيني متداخل للغاية مع بقية العالم، لدرجة أن أي اضطراب يقوم به الرئيس شي قد يرتد إلى وجهه، منفجرا فيه.

"يريد الصينيون أن يستفيدوا، قدر ما استطاعوا، من المشاركة في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد"، كما قال جابوِيف، مضيفا أن "توصيف ما تعنيه القوة العظمى فعليا (بالنسبة إلى الصين) أمر براغماتي للغاية، وبعيد كثيرا عن التوصيف العاطفي، وأكثر حلما على المدى الطويل من هوس بوتين بالهيمنة على أوكرانيا".
والحال أنه مع تعاظم قوة الصين، فإن الفجوة في مصالح البلدين قد تتسع، إذ "يريد شي أن يهيمن فعليا على الاقتصاد الروسي من خلال التكنولوجيا، وعبر إدماج روسيا في [عالم الهيمنة الصينية (Pax Sinica)] بوصفها شريكا أصغر، ورغم حرصه على إبداء الاحترام الرسمي لسيادتها، فإنه يريد جعل اقتصاد موسكو وسياستها الخارجية أكثر تماشيا مع مرامي السياسة الخارجية الصينية" كما يقول جابويف. وفي حين أن الصين حتى هذه اللحظة "ليست في مكانة تمكِّنها من إجبار روسيا على القيام بذلك، فإنه بعد 10 سنوات أو 15 سنة من الآن، سيكون هذا أمرا ممكنا للغاية، وهذا هو مكمن الخطر بالنسبة إلى روسيا".
بهذا المعنى، فإن الصداقة بين بوتين وشي قد تكون صداقة خطرة لكل منهما على الآخر، كما هي خطرة بالنسبة إلى واشنطن، ولعل ذلك قد اتضح لهما مع تطور الأحداث في أوكرانيا. فقد أتت شراكتهما أكلها في بعض المناحي، حيث حظي بوتين بدعم دبلوماسي قيّم من شي. ومن منظور بكين، فروسيا تقوم بعملها على أكمل وجه في صد الديمقراطية. لكن بكين رسمت خَطّا بين المخاوف الأمنية لدى بوتين التي وصفتها بأنها "مشروعة"، وبين حربه التي لم تُدِنْها، ولكنها في الوقت نفسه لم تؤيدها بصورة واضحة، فقد امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إجراء ينكر الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
السبب في ذلك جزئيا هو الأيديولوجيا، إذ تدعو الصين إلى أن تستند العلاقات الدولية إلى مبدأ "عدم التدخل" في شؤون الدول الأخرى، وفي حين أنه لا يوجد شكل أعظم من الاجتياح للتدخل في شؤون الدول الأخرى، فإن عدوان بوتين إنما يضع شي في موضع أخرق دبلوماسيا. وقد شدَّد المسؤولون الصينيون مرارا في تعليقاتهم بخصوص أوكرانيا على أهمية احترام سيادة الدول.
الأهم من ذلك هو أن المصالح القومية الصينية ستحدد مقدار الدعم الذي يمكن لشي أن يقدمه لروسيا. فمثلا، رغم أن بكين عارضت العقوبات التي فُرِضت على روسيا، ولربما تجد سُبلا لمساعدة بوتين كي يتفادى هذه العقوبات، فإن الصين مندمجة في الاقتصاد العالمي إلى درجةٍ لا تتيح لها المخاطرة بأن تُفرض عقوبات عليها هي نفسها. وقد بدأت البنوك الحكومية الصينية، عقب إعلان العقوبات، بتقييد ائتمان المشتريات للسلع الروسية، فيما علق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم صينيا نشاطاته المرتبطة بروسيا. "الأكثر رجحانا هو أن الصين ستدعم روسيا ماليا ومن خلال التجارة بقدر ما تسمح به أي عقوبة غربية مفروضة"، كما كتب كبير الاقتصاديين الآسيويين "مارك ويليامز" في مركز "كابيتال إكونوميكس" في تقرير له في فبراير الماضي. "فلن تخاطر الشركات الكبرى أو الحكومة بمزيد تمزّقٍ فيما يتعلق بالعلاقات مع الغرب".
الصين أولا

هنا يكمن مربط الفرس. إن أولوية الصين، في نهاية المطاف، هي الصين دائما. لقد شددت بكين حتى الآن على أن صداقتها مع موسكو "شديدة الصلابة"، وأنها ستساعد بوتين (أو أي شخص آخر، في هذا الصدد) ما دام أن هذا لا يضر بأجندتها. يعني هذا أن الزواج بين شي وبوتين قد يبقى ضربا من زواج يلائم الطرفين ليس إلا. تجدر الإشارة إلى أن كليهما لا يزال بإمكانه أن يزعج الولايات المتحدة وأصدقاءها، لكنهما سوف يعانيان من أجل بناء تحالف حقيقي على شاكلة الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان أو بريطانيا، حيث إن الأطراف في تلك الشراكات مستعدة لتنسيق العمل والسياسات.
لقد أسدى بوتين خدمة جليلة إلى شي، ألا وهي الكشف عما قد يحدث في حال بدأت الصين حربها هي، حيث أوضح اجتياح بوتين بجلاء أن نسق التحالفات الأميركية لا يزال حيا، خلافا لما يبدو أن قادة بكين يعتقدونه. لربما ينظر الحزب الصيني الشيوعي، المهووس بالاستقرار الداخلي، بعين يملؤها الانزعاج إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ويحسب تكلفة تحمُّل عقوبات مثلها. لقد توقع كثيرٌ من المعلقين بأن الأزمة الأوكرانية ستكون نذيرا لهجوم عسكري صيني مماثل على تايوان، بيد أن ما حصل هو العكس، حتى الآن.
إذن، السؤال المطروح الآن هو كيف يستجيب الرئيس شي لكل تلك التحوُّلات؟ لقد ناشدت الحكومة الأوكرانية بصورة مباشرة الصين بأن تستخدم نفوذها لدى بوتين كي يوقف هذه الأعمال العدائية. وحسب علمنا، بقيت بكين في فكاك من التزامها بذلك. ولذا، يواجه شي خيارا ثقيلا، حيث يمكنه أن يغتنم تلك الفرصة ليكون الرجل العالمي الخَيّر ويتدخل نيابة عن أوكرانيا في تلك الأزمة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من مواجهة الصين مع الولايات المتحدة في هذه المسألة، ومن ثم يموضع حكومته بوصفا لاعبا بنّاءً في الشؤون الدولية، أو بوسعه أيضا أن يظل على موقعه الحالي الداعم لبوتين، ساعيا وراء هدفه طويل الأمد لفك عرى القوة الأميركية. لعل النتيجة الأكثر ديمومة جراء حرب بوتين في أوكرانيا ستكون هي تحديد طبيعة الدور الذي ستلعبه الصين في العالم.
—————————————————————————————
هذا المقال مترجم عن The Atlantic
ترجمة: كريم محمد.
المصدر : الجزيرة نت