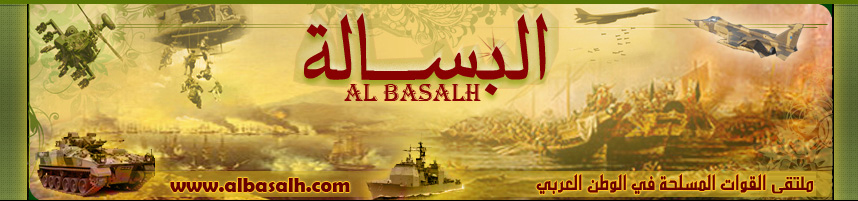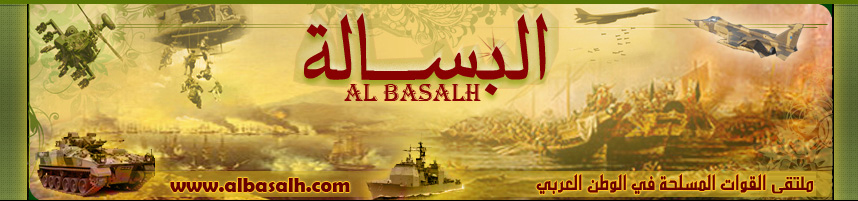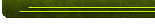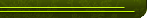نشأة عباسية
قبل ثمانية قرون؛ نشأت دولة مهمة في منطقة قلب العالم الإسلامي -التي تُعرف اليوم بالشرق الأوسط- عرفت بدولة المماليك، وكان لظهورها واستمرارها ثم ضعفها ونهايتها قصة مثيرة تؤكد لنا ما توقّعه المؤرخ الحضاري
وليُّ الدِّين ابن خَلْدُون (ت 808هـ/1406م) حين انتبه -في كتابه ‘المقدمة‘- إلى أن بداية وهن الدول يبدأ مع شيوع الترف فيها، فإذا أهلها "ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تبنّقوه (= تأنّقوا فيه) من النعيم وغضارة العيش، فيصيرون عالة على الدولة، ويفقدون العصبية بالجملة، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة".
وقد عاش المماليكُ هذه الحقيقة في مبتدئهم ومنتهاهم، واللافت أن ابن خلدون جاء إلى مصر -في عام 784هـ/1383م- لاجئاً من كروب السياسة في منطقة الغرب الإسلامي، وصادف مقدمه إليها السنة الأولى من العصر الثاني للدولة المملوكية (784-923هـ/1382-1517م) الذي قادها فيه "المماليك الجَرَاكسة/الشَّرَاكسة".
وقد أفضى إلينا هذا القاضي المؤرخ بحديث فريد عن هذه المرحلة من حياته وحياة المماليك دولة ورعية؛ فقد أخذته القاهرةُ المملوكية -التي رآها في ذروة مجدها الإسلامي والحضاري عند دخولها- فوصفها بأنها "حاضرة الدنيا وبستان العالم، ومحشر الأمم، ومدرج الذر من البشر، وإيوان الإسلام، وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين (= جمع إيوان: مجلس بثلاثة جدران ومفتوح على صحن مبناه) في جوّه، وتزهر الخوانق والمدارس والكواكب بآفاقه، وتضيء البدور والكواكب من علمائه"!!
رأى ابن خلدون إذن القاهرة في لحظة انتقالها إلى عهد جديد إثر صراع مرير بين صنفيْ المماليك: الأتراك والشراكسة، وكان الأتراك في الأصل سادة للشراكسة، وقد وصف ابن خلدون سيطرتهم العددية بقوله إن "أكثر.. التُّرْك الذين بديار مصر من القفجاق".
وفي هذا العهد الجديد تغيرت أهم القواعد الأخلاقية والعسكرية التي قامت عليها الدولة المملوكية، كما لاحظ ذلك تلميذه
الإمام المؤرخ تقي الدين المقريزي (ت 845هـ/1442م) -في كتابه ‘المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‘- الذي وصف هذا العهد بأنه شهد "سِني الحوادث والمحن التي خربت فيها ديار مصر، وفنيَ معظم أهلها، واتَّضَعتْ بها الأحوال، واختلت الأمور خللا أذِنَ بدمار إقليم مصر".
والواقع أن ذلك المجد الراسخ -الذي لاحظه ابن خلدون لحظة اختياره مصر المحروسة وطنا بديلا له- كان يخفي وراءه ضعفا دفينا ظلت ملامحه تتبدَّى وتزداد، منبئةً عن مقدمات وأسباب ونتائج جعلت الأتراك العثمانيين -في نهاية المطاف- يسحقون هذه الدولة المملوكية، ويستولون على أقطارها -حين طمحوا إلى السيطرة عليها- في ظرف أشهر معدودات على يد السلطان سليم الأول (ت 926هـ/1520م).
يرجع تأسيس دولة المماليك إلى فئة "المماليك الأتراك" وهم العبيد البِيضُ المجلوبون من بلاد "ما وراء النهر" (نهر جيحون) في آسيا الوسطى، وتعود ظاهرة جلبهم إلى فترة مبكرة من عمر الحضارة الإسلامية، لاسيما في العصر العباسي بدءا من أيام الخليفة المهدي (ت 169هـ/787م) وابنه هارون الرشيد (ت 193هـ/809م)، ثم تعاظم حضورهم في عهد المأمون العباسي (ت 218هـ/833م) وأخيه وخليفته المعتصم (ت 227هـ/842م) ثم الواثق بالله بن المعتصم (ت 232هـ/847م).
ويحدثنا ابن خلدون -في تاريخه- عن تدرُّج هؤلاء المماليك الأتراك في سلّم المجتمع الإسلامي، بداية من عملهم في الصنائع والمهن، ومرورا بانخراطهم في الجيوش جنودا مقاتلين، ودخولهم دواوين الحكم مديرين مدبّرين وكَتَبَة مثقفين، وانتهاء بتبوّئهم أعلى مناصب السلطة العسكرية والسياسية قادةً وأمراء وسلاطين.
فهو يذكر أن الخلفاء العباسيين استكثروا من جلب المماليك الأتراك وكانوا "يسلمونهم إلى قَهارمة (= خبراء) القصور وقَرَمَة (= سادة) الدواوين، يأخذونهم بحدود الإسلام والشريعة، وآداب الملك والسياسة، ومِراس الثقافة (= التدريب العسكري) في المران على المناضلة بالسهام والمسالحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح، والبصر بأمور الحرب والفروسية، ومعاناة الخيول والسلاح، والوقوف على معاني السياسة"، حتى إذا أتقنوا تلك الفنون "ملئوا منهم المواكب في الأعياد والمشاهد، والحروب والصوائف والحراسة على السلطان، زينةً في أيام السلم وإكثافا لعصابة الملك".
ثم لم تمض سوى عقود على حشود هؤلاء المماليك المجلوبين والمدرَّبين حتى "سَمَوْا في دُرَج الملك، وامتلأت جوانحهم من الغزو، وطمحت أبصارهم إلى الاستبداد؛ فتغلبوا على الدولة وحجروا الخلفاء، وقعدوا بدست (= كرسي) الملك ومدرج النهي والأمر، وقادوا الدولة بزمامهم وأضافوا اسم السلطان إلى مراتبهم، وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل (الخليفة العباسي المتوفى 247هـ/861م) وما حصل بعدها من تغلب الموالي واستبدادهم بالدولة والسلطان، ونَهَجَ (= هَيّأ) السلفُ منهم في ذلك السبيلَ للخلف واقتدى الآخر بالأول، فكانت لهم دُوَلٌ في الإسلام متعددة تعقب غالبا دولة أهل العصبية وشوكة النسب"؛ وفقا لابن خلدون.
وبذلك مثَّل العصر العباسي الحقبة الأولى لصعود نجم "المماليك الأتراك" العسكري ثم السياسي في سماء العالم الإسلامي، حين شكّلوا عماد الجيوش العباسية مما فتح لهم باب النفوذ الطاغي على بلاط الخلافة في بغداد، بدءا من منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي حين أقدم قادتهم على تنفيذ أولِ عمليةِ قتلٍ لخليفةٍ عباسيٍ باغتيالهم المتوكل.