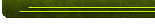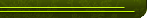ومع كل ذلك، وحتى لحظة استقالته، بقيت مفاتيح الفناء الشامل، نظام "التحكم والسيطرة على السلاح النووي"، ذلك الكيان المعقّد والدقيق الذي يمنح الرئيس سلطة إطلاق أسلحة قادرة على محو مدن بأكملها وقتل ملايين البشر، محفوظة في يده المضطربة، مثلما كانت مع رؤساء أميركا الأربعة الذين سبقوه بعد
الحرب العالمية الثانية، ومثلما بقيت مع من جاؤوا بعده.
على مدى 80 عامًا، ظل رئيس الولايات المتحدة وحده، دون سواه، يملك الكلمة التي تطلق العنان لجحيم السلاح النووي، فإذا قرر توجيه ضربة مباغتة لا مبرر يسوّغها، أو تصعيد نزاع تقليدي إلى مستوى نووي، أو الردّ على هجوم نووي محدود بحرب شاملة، فإن القرار يظل بيده وحده.
لا يملك أحد في الحكومة أو الجيش حق الاعتراض، ولا وجود لصوت يعلو فوق صوته في تلك اللحظة الفاصلة. لقد بلغ هذا التفرد بالسلطة حدًّا جعل الأوساط الدفاعية على مدى عقود تُطلق على السلاح النووي اسم "سلاح الرئيس".
مرّ معظم الرؤساء بلحظات من اضطراب شخصي، وربما بضعف مؤقت في القدرة على اتخاذ القرار الصائب. فقد نُقل
دوايت آيزنهاورإلى المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أثار نقاشًا وطنيًا حول مدى أهليته للاستمرار في المنصب والترشح لولاية ثانية. أما جون كينيدي، فكان يتلقى سرًّا أدوية قوية لعلاج داء أديسون، وهو مرض قد يسبب إنهاكًا شديدًا وتقلّبات حادة في المزاج.
والأمر ذاته ينطبق على رونالد ريغان،
وجو بايدن، كلٌّ بدوره بلغ عتبات الشيخوخة، وواجه التحديات المترافقة مع تقدم العمر.
وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها، ترقد في أحد جيوب
دونالد ترامب بطاقة بلاستيكية صغيرة تحمل رموزًا سرية للغاية، وهي مفتاحه الشخصي إلى الترسانة النووية، بينما ينشغل بإظهار مظاهر الهيمنة، ويغلي غضبًا من خصوم حقيقيين أو من نسج خياله، ويترك المعلومات المضلّلة تؤثّر في قراراته، بينما يحترق العالم من حوله بنيران الحروب الإقليمية المتناثرة.
على مدى ما يقارب 30 عامًا بعد نهاية
الحرب الباردة، خُيّل إلى العالم أن شبح الحرب النووية قد توارى، أو على الأقل خفت صوته. إلا أن العلاقات مع روسيا عادت إلى التوتر الشديد، وشق دونالد ترامب طريقه إلى المشهد السياسي.
ورغم تصريحاته العلنية حول استعداده لإطلاق "النار والغضب" ضد قوة نووية أخرى، ورغم ما نُقل عنه من رغبة في زيادة الترسانة النووية الأميركية إلى نحو 10 أضعاف، بعد أن تساءل ذات مرة أمام أحد مستشاريه عن جدوى امتلاك السلاح النووي إذا لم يستطع استخدامه! رغم ذلك كله، منحه الناخبون رموز السلاح النووي، لا مرة واحدة بل مرتين.
في المقابل، واصلتْ روسيا التلويح بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي في حربها المستمرة ضد أوكرانيا، حيث تتماس الحدود مع 4 دول من حلف الناتو. وفي مايو/أيار الماضي، عادت الهند وباكستان -الجاراتان النوويتان المتنازعتان- إلى الاشتباك الدموي حول إقليم
كشمير.
أما كوريا الشمالية، فتمضي قدمًا في خططها لتحديث وتوسيع قدراتها النووية، بما يشكّل تهديدًا للمدن الأميركية ويزيد من حدة التوتر في كوريا الجنوبية، حيث بدأ بعض القادة يناقشون إمكانية تطوير قنبلة نووية محلية.
وفي يونيو/حزيران، شنّت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضد إيران، بعدما أعلنت إسرائيل عزمها إنهاءَ التهديد النووي الإيراني الناشئ الذي ترى فيه خطرًا وجوديًا.
إذا اندلعت أيٌّ من هذه النزاعات، فإن القرار النووي يبقى مرهونًا بمنظومة القيادة والسيطرة التي تتوقف في جوهرها على سلطة الرئيس وإنسانيته كذلك. إنه النظام
المعتمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن يبقى السؤال المهم: "هل لا يزال هذا النظام قائمًا على منطقٍ يُعتدّ به في عالم اليوم؟".
سواء أكان الرئيس يأمر بضربة نووية استباقية ضد عدو، أو يردّ على هجوم استهدف بلاده أو أحد حلفائها، فإن الإجراءات المتّبعة تظل واحدة؛ إذ يبدأ بالتشاور مع كبار مستشاريه من المدنيين والعسكريين، وإذا اتخذ قراره باستخدام السلاح النووي، فإنه يستدعي حينها "الحقيبة النووية"، وهي حقيبة من الألمنيوم مكسوّة بالجلد، تزن نحو 45 رطلاً (20 كلغ)، ويحملها مساعد عسكري لا يفارق الرئيس أينما ذهب.
وفي العديد من الصور التي توثّق جولات الرؤساء، يمكن ملاحظة هذا المساعد في الخلفية، ممسكًا بالحقيبة في صمت.
لا تحتوي هذه الحقيبة على ما يشبه الزر السحري الذي سيطلق الأسلحة النووية، ولا على أي وسيلة تمكّن الرئيس من تنفيذ الضربة النووية بنفسه، فالحقيبة ليست أكثر من أداة اتصال مُصممة لربط القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقر
البنتاغون بسرعة وموثوقية في لحظات الطوارئ القصوى.