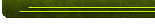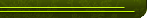الخطاب السياسي و جدلية العلاقة بين المتكلم والمتلقي والمكان
أ-د/إبراهيم خليل العبد ابراش Wednesday 29-04 -2009 
- مِن مَن يجرؤ على الكلام؟ إلى جدوى الكلام؟-
إلى زمن ليس بالبعيد كانت حرية الكلام هي محك العلاقة بين المثقف والسلطة في العالم العربي.كان المثقف أو المعارض السياسي معرضا للاعتقال بل والاغتيال لمجرد انتقاده للسلطة ،وكان الشغل الشاغل لأجهزة الأمن في الداخل وعلى الحدود مراقبة كل كلمة تقال وتُكتب والتدقيق في كل صحيفة ومنشور، حتى باتت كل كلمة تتطرق للشأن السياسي تُعَرض صاحبها للعقاب،الصحافة ممنوعة أو مُراقبة، الكتب والصحف الأجنبية ممنوعة من دخول البلاد أو تخضع للرقيب ،هذا ناهيك عن الغياب الكلي للإذاعات والفضائيات الخاصة خصوصا إن كانت خاضعة للمعارضة إلا ما لا يمكن لتقنيات الأنظمة منعها من اختراق موجات الأثير.بفضل الثورة التقنية والمعلوماتية وضغوط الخارج وشيئا من التنمية السياسية التي فرضها نضال الشعوب،انتقلنا من حالة المنع المطلق إلى ما يشبه (فوضى الحرية) بالنسبة للقول والكتابة، ولكن في نفس الوقت ظهرت قوى وثقافات جديدة لا تقل تهديدا للحريات من الأنظمة السياسية.
وعليه لم تعد أهمية الكلام والخطاب السياسي اليوم تكمن في وضوح مفرداته وجمالية نصه أو في ما يحتويه من عبارات تُشخص الواقع وتُحلله وتُنقده ،هذا أمر مطلوب ولكنه لا يكفي لأنه من هذه الناحية لا تختلف كتابات السياسيين والمثقفين الأجانب الذين يعيشون في الدول الديمقراطية عن كتابات مثقفين وسياسيين عرب ، من حيث احتوائها على التنظير السياسي والنقد والدعوة للتغيير،إذن أهمية الخطاب لم تعد في النص بل تكمن أهميته في فعله وأثره المتولد عنه سواء من حيث تأثيره على الرأي العام أو من خلال إنتاج رأي عام جديد وثقافة جديدة أو بشكل عام من خلال تأثيره على مجريات الواقع وخلق علاقة تفاعلية بينهما.
للمثقف و للخطاب السياسي تأثير في المجتمعات الديمقراطية لأنه يوجد لديهم رأي عام فاعل ولأن السياسيين وأصحاب القرار يحسبون حسابا للرأي العام ويضعونه في اعتبارهم لأن الشعب هو الذي انتخبهم وبالتالي يعنيهم كسب ثقة الشعب كي يستمروا في السلطة ويضمنوا انتخابهم مرة أخرى بالإضافة إلى الحرص على المصلحة الوطنية التي هي محل إجماع وطني تقريباٍ ولأن المثقفين في الغرب ذوو مصداقية واحترام سوء من قبل الشعب أو من قبل ذوي السلطة،أما في حالتنا العربية ومع افتراض وجود رأي عام فإن تأثير المثقفين أو أصحاب الخطاب السياسي العقلاني والديمقراطي على الرأي العام ضعيفا ،وتأثير الرأي العام المُفترض على أصحاب القرار غير واضح وغير مؤثر,فهناك علاقة متوترة ما بين المثقف والسلطة وما بين المثقف والشعب وما بين الشعب والسلطة، فالشعب لم ينتخب ممثليه السياسيين , حتى إن جرت انتخابات فالنتائج تكون مضمونة مسبقاً لصالح النظام القائم،هذا بالإضافة إلى غموض مفهوم المصلحة الوطنية التي يفترض أن تحكم وتوجه السلوك السياسي.
إذن الفرق بين الخطاب السياسي في الدول الديمقراطية والخطاب السياسي في عالمنا العربي لا يكمن فقط في مفردات الخطاب ولا في اختلاف هامش الحرية في الحالتين ولكن في العلاقة الجدلية التي تحكم الخطاب بالواقع أو علاقة المتكلم بالمتلقي وبالمكان.
منذ سنوات كتب النائب الأمريكي السابق في الكونجرس بول فندلي كتاباً بعنوان (من يجرؤ على الكلام ؟) وهو كتاب أثار ضجة كبيرة في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية حيث تحدّث عن الهيمنة الصهيونية على السياسة الأمريكية وحالة الإرهاب الممارس ضد كل من يجرؤ على نقد الهيمنة التي تمارسها إسرائيل واللوبي الصهيوني على أصحاب القرار في واشنطن،وكان فندلي نفسه أحد الذين دفعوا الثمن غالياً بسبب جرأته على قول الحقيقة،وهناك كثيرون ممن دفعوا ثمن قول الحقيقة بدءا من سقراط في أثنا قبل الميلاد مرورا بابن رشد مؤسس العقلانية العربية الإسلامية المُجهضَة إلى روجي غارودي في فرنسا الذي شكك في الرواية الصهيونية حول الهولوكست في كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ) 1996 وجالاوي في بريطانيا الذي شكك في الرواية الأمريكية لمبررات احتلال العراق وشكك في أهداف الحملة الأمريكية ضد الإرهاب .كثير من الكُتَّاب الأجانب كان خطابهم السياسي محركاً للرأي العام وأثر على أصحاب القرار وعلى الواقع إن السبب الجوهري لذلك هو وجود رأي عام أو متلقي متجاوب ،لأنه يفهم الخطاب ويثق بصاحبه فأنه يتفاعل معه. ولكن ما هو الحال بالنسبة للعالم العربي ؟.
لا غرو أن كثيراً من المثقفين والمعارضين للنظام والمواطنين العاديين في عالمنا العربي دفعوا ثمناً باهظاً لمجرد أنهم جرؤوا على الكلام وقالوا الحقيقة بدوافع وطنية خالصة وجرؤوا على نقد الاستبداد في بلدانهم ولا ضرورة لسرد آلاف الحالات ، بعضها توفي في السجون وبعضهم أمضى السنوات الطويلة فيها وبعضهم اختفى ولا يعرف ذووهم مصيرهم وبعضهم خرج من السجن وتحدث عن تجربته المريرة وهناك أيضا من خرج من السجن ليتبوأ مراكز قيادية عند نفس النظام الذي اعتقله !.المشكلة في العالم العربي لم تعد بالجرأة على الكلام فقط فالفضائيات والمواقع الالكترونية فتحت الباب لكل من هب ودب ليتكلم وينتقد بلا حدود أو ضوابط حتى بات هذا الفضاء يعرف (فوضى الحرية)،المشكلة تكمن في شخص المتكلم , ولماذا يتكلم؟وأين يتكلم في بلده أم خارجه؟وبمدى توافق كلامه مع فعله؟أو تأثيره على المتلقي؟ حيث لا يكون للكلام تأثير وفعل مُغير للواقع إلا إذا توفر رأي عام حقيقي وحالة ثقافية سياسية تسمح بان يكون للكلام تأثير على الواقع،فالمتلقي يكون أحياناً أهم من المتكلم ؟.
هذا ما يفسر ما نشاهده في الفترة الأخيرة في مجتمعاتنا العربية من عدم التناسب بين تضخم الخطاب السياسي وتطوره من جانب وبؤس الواقع السياسي والثقافي من جانب آخر.
لقد استحقت أنظمة عربية - بجدارة - المرتبة الأولى في سلم تصنيف المنظمات الحقوقية الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم , وهذا معناه أن في العالم العربي كثيرين ممن جرؤوا على الكلام وكان مصيرهم الاعتقال والتعذيب والقتل وكل أشكال التضييق على الحياة ،ولكن ليس كل من يتكلم منتقدا يُعتقل وليس كل من يُعتقل لأسباب سياسية يعتقل لأنه انتقد فقط.وبالتالي ليس كل من يُضطهد من طرف الأنظمة برئ وليس كل من يتكلم يقول الحقيقية أو يندرج ضمن مناضلي الرأي ، فهناك من يستحقون ما جري لهم وخصوصاً الذين يمارسون الإرهاب أو يلجأون للنقد الهدام مدفوعين بالسعي للشهرة أو لمصلحة خاصة أو منفذين لأجندة خارجية،وفي كثير من الحالات يكون مصدر معاناة المواطن والمثقف والتضييق على حريته الشخصية والفكرية ليس السلطة بل ثقافات خاطئة توظّف الدين والايدولوجيا لتشكل حالة من الترهيب على المجتمع.
قبل عقود سواء في ظل الاستعمار والانتداب أو السنوات الأولى للاستقلال كانت السلطة هي العائق الرئيس لممارسة الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير،كانت السلطة السياسية في كل بلد، سواء كان النظام ثوريا وتقدميا أو يمينيا ومحافظا، يُشار إليها كقامعة للحريات ومنتهكة للحقوق ومعيقة للتنمية السياسية والثقافية .ولكن فيما بعد ومع التحولات التي عرفتها النظم السياسية العربية والتغير في المجتمعات والنخب وبفعل ضغوط الخارج واستحضار الماضي مدججا بالأيديولوجية السياسية،لم يعد الخوف من الكلام مصدره السلطة فقط بل من المجتمع أيضا،من ثقافات وجماعات وأحزاب نصَّبت نفسها ناطقة باسم الأمة أو الدين أو الوطنية وبعضها عابر للوطنيات والحدود.لم يعد المواطن وحده لا يجرؤ على الكلام بل والنخب المثقفة والنخب السياسية أحيانا،وفي كثير من الحالات وجد المثقفون أنفسهم يصطفون إلى جانب النظام الذي كانوا يعادونه في مواجهة ما يعتبرونه عدوا مشتركا ،لم يعد المثقف معرضا للاعتقال والقمع من طرف السلطة فقط بل من طرف جماعات تملك من أدوات القمع ما يتفوق أحيانا على ما عند السلطة السياسية ،وتمنح نفسها حق العقاب بما يفوق العقاب الذي تُوقِعه السلطة وكثيرا ما يكون عقابا يصل لحد القتل وبدون محاكمات.وبالتالي أصبح المثقف والسياسي العقلاني واقعا ما بين مطرقة النظام وسندان قوى وثقافات تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة.
التغير لم يقتصر على العلاقة ما بين الخطاب والمتلقي والسلطة بل مس أيضا المكان ،أو أن التغير في العلاقة الأولى أمتد للمكان.قبل سنوات كانت غالبية المعارضة السياسية العربية تهرب من أوطانها إلى الخارج – أوروبا وأمريكا الشمالية-والذي يُفترض أن يكون الخصم والعدو للأمة،وقلة إلى دول المعسكر الاشتراكي سابقا،وكانت قوى المعارضة المقيمة في الغرب من كل المشارب السياسية، من جماعة الإخوان المسلمين إلى القوميين وحتى جماعات اليسار والثورية،وبالتالي كان صوت المثقفين والمعارضين المقيمين في الخارج أعلى من صوت المثقفين والمعارضين الصامدين في بلدانهم ،ولكن تأثير هؤلاء الأخيرين كان أقوى وأكثر مصداقية.مع التغيرات المشار إليها أعلاه عاد المثقفون والمعارضون إلى بلدانهم بعضهم على ظهر دبابات أمريكية وآخرون ضمن تفاهمات مع نظام الحكم في بلدهم وفريق ثالث عاد بقوة التأييد الشعبي وضد إرادة النظام.لم يعد المكان محَدِدا للحرية ولكن مفهوم الحرية وتأثير ودور المثقفين والمعارضين هو الذي أصبح يحتاج إلى تعريف جديد ومقاربات جديدة.لم يعد السؤال اليوم مَن يجرؤ على الكلام بل عن جدوى الكلام؟.