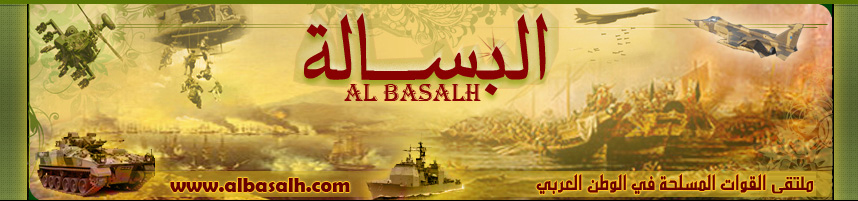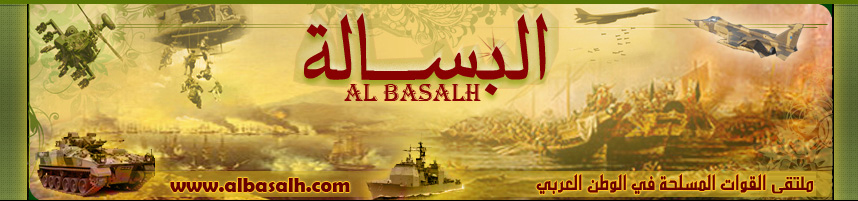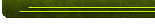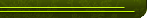مُنِيت ألمانيا بهزيمة مذلّة في الحرب العالمية الأولى، ترتب عليها اقتطاع أجزاء من أراضيها، وتسريح جيشها، وفرض حصار مالي وعسكري عليها، وإلزامها بتعويضات ضخمة للدول المنتصرة في الحرب، وتقسيم مستعمراتها في العالم بين بريطانيا وفرنسا.
وفي سنوات الانكسار الألماني، شاع الحديث عن راتزل الذي عاش فترة الوحدة والتوسع الجيوسياسي لألمانيا حتى وفاته عام 1904، وكانت القوة الألمانية حينها تتمدد برا وبحرا، وتؤثر في هندسة الخرائط الدولية، كما حدث في مؤتمرات التقسيم التي احتضنتها برلين. وقد جاء من بعده هاوسهوفر، الذي عاش مرحلتَي الطفرة والانهيار، وشهد الانتصار والانكسار، حتى وفاته عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
حشد هاوسهوفر فريقا من الجغرافيين والسياسيين الألمان، وأصدروا لأول مرة دورية علمية باسم "المجلة الجيوسياسية"، وحاولوا عن طريقها إعادة تشكيل الفكر القومي، وقد ارتبطت ببدايات المد النازي في ألمانيا.
وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الألمانية، أُنشئت المدرسة الجيوسياسية عام 1924 برئاسة هاوسهوفر، الذي نُظِر إليه بوصفه أحد العقول التي ألهمت الزعيم النازي أدولف هتلر، حيث تبنَّى الأخير الكثير من أفكار هاوسهوفر ومدرسته، كما استعان بأفكار المفكر الإنجليزي هالفورد ماكيندر، المعاصر للحقبة نفسها، وهو أحد روَّاد الجغرافيا السياسية آنذاك.
اعتمد هتلر مفهوم المجال الحيوي لألمانيا، أي تلك المساحة الجغرافية التي تليق ببلاده كما رآها، وتليق بالجنس الآري، وقد شكَّلت تلك أهم مقومات الأيديولوجيا القومية النازية التي سعت لتحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، أولها وحدة ألمانيا (استعادة الأراضي التي اقتُطِعَت منها بعد الحرب العالمية الأولى)، وثانيها وحدة الألمان (ضم كل الشعوب الألمانية في أوروبا في دولة واحدة)، وثالثها وحدة أوروبا تحت قيادة ألمانيا، وهو ما يعني الانتقال التدريجي من فكرة "النفوذ" إلى فكرة "السيطرة" و"الهيمنة".
بعد الانهيار الألماني إثر الحرب العالمية الثانية، اعتقد البعض أن الجغرافيا السياسية انتهت، لكن مفكرين إستراتيجيين مثل بيتر تيلور طوَّروا مفاهيم جديدة للجغرافيا السياسية لتفسير القوة الصاعدة آنذاك للولايات المتحدة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي أكبر قوة عالمية.
ومن تلك المفاهيم مفهوم "الحدود الشفافة"، أي فرض الهيمنة الاقتصادية والعسكرية دون سيطرة مباشرة على الأرض، وهو ما أسماه تايلور "جغرافيا السيطرة دون إمبراطورية"، التي جعلت من العالم بقاراته المختلفة مجالا حيويا لبعض الدول العظمى، وهو أمر ترسَّخ بعد انهيار
الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتحوُّل النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة.
لم تدُم نشوة القطب الواحد طويلا، وسرعان ما اهتزت القيم النيوليبرالية بعد الأزمة المالية العالمية، وكذلك بعد أن ظهر بجلاء فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها من احتلال أفغانستان والعراق، ومن ثمَّ ظهرت نزعات نحو مراجعة أفكار التسعينيات، وبداية تطوير أفكار جيوسياسية جديدة منفصلة عن المفاهيم الأميركية.
اللافت هُنا أن الرئيس الأميركي يسعى اليوم للانتقال من النفوذ إلى السيطرة، ومن الحدود الشفافة إلى الهيمنة الخشنة، ومن ثمَّ تصبح في نظره كندا الولاية 51 لا مجرد شريك تجاري مجاور فحسب، وكذلك غرينلاند وقناة بنما، في عملية فرض هيمنة خشنة لم يعهدها حلفاء واشنطن.
في المجمل، تظل قراءة العلاقات الدولية من منظور تفاعلات الصراع والتعاون بين القوى الدولية في حاجة حقيقية إلى المنظور الجيوسياسي، حتى تكتمل الرؤية الإستراتيجية لما يشهده العالم من تحوُّلات، سواء كانت هذه التحولات انتقالية أو جذرية، وسواء انقشعت سريعا أم بقيت معنا لعقود طويلة، وينطبق ذلك على ما يفعله ترامب اتجاه كندا والمكسيك وغرينلاند، وما ينفذه نتنياهو اتجاه الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية.