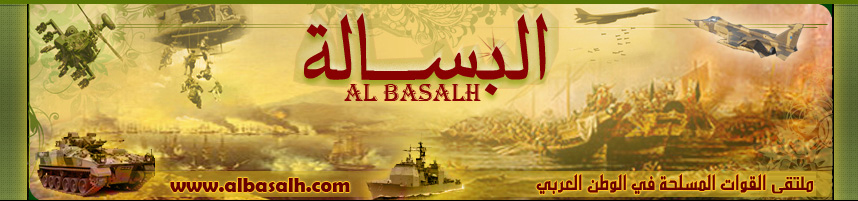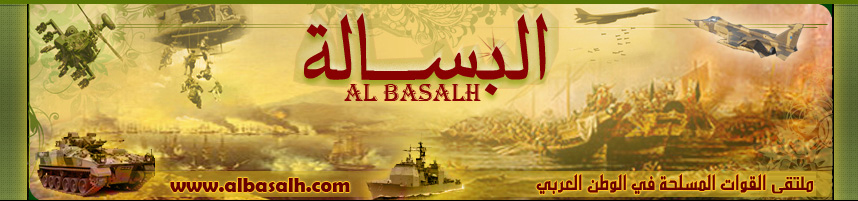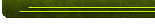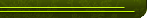حكومة ثورية
وخلال تلك المدة القليلة تلقّب النفس الزكية بـ"أمير المؤمنين" لمبايعة الناس إياه بالخلافة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ثورات البيت العلوي، وهو ما يؤكده الإمام ابن حزم الأندلسي بقوله -في ‘رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء‘- إنه "لم يَتَسَمّ أحدٌ من ثوار بني علي رضي الله عنه بالخلافة -على كثرة القائمين منهم- إلا محمد بن عبد الله" واثنان جاءا من بعده.
كما قدّم النفس الزكية خطابا سياسيا يتهم فيه العباسيين بارتكاب مظالم ومآثم؛ فطوال ثلاث عشرة سنة مضت من حكمهم حتى تلك اللحظة "نَجَمَ الجور، وخُولف الكتاب، وأُميتت السنَّة، وأُحييت البدعة". وفي المقابل عرض النفس الزكية خلاصة برنامجه السياسي قائلا: "ونحنُ ندعوكم أيُّها الناس إلى الحكم بكتابِ الله، وإلى العمل بما فيه، وإلى إنكار المنكر، وإلى الأمر بالمعروف"؛ طبقا لإحدى خطبه أوردت نَصَّها كُتُب الزيدية ونقلها عنها الدكتور رضوان السيد في كتابه ‘النفس الزكية: كتاب السِّيَر وما بقي من رسائل الدعوة والثورة‘.
كذلك أقدم النفس الزكية على اتخاذ سلسلة من القرارات الكبرى تدل على جاهزية للتقرير وسرعة في التنفيذ، كما لو أنه فعلا أصبح ذا دولة مستتبة السيادة. وكان أول قراراته الإفراج عن المعتقلين "فأتى السجن... فدقّه وأخرج من كان فيه" من المساجين؛ طبقا للطبري الذي يقول أيضا إنه جاء ليلا "فدقَّ السجن وبيت المال" بعد سيطرته على الوضع الأمني واعتقال أبرز رجال الإدارة العباسية بقيادة واليهم على المدينة رياح بن عثمان بن حيّان المري (ت 145هـ/763م).
كما شكّل النفس الزكية سلطة لإدارة شؤون الدولة وكان من اللافت أن اثنين من المعيَّنِين فيها من تلامذته الذين درسوا عليه قبل الثورة؛ وقد زوّدنا الإمام الطبري بأسماء شاغلي المناصب السيادية في هذه السلطة (وزارات العدل والداخلية والمالية والدفاع)، فقال إنه "لما أخَذ محمد المدينة استعمل عليها عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير (ت 145هـ/763م)، وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي (ت 158هـ/776م)، وعلى الشُّرَط (= الشرطة) أبا القَلَمَّس عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت بعد 145هـ/763م)، وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مَخْرَمَة (ت 170هـ/786م)...، [كما] استعمل... عبد العزيز ابن الدَّرَاوَرْدي (ت 186هـ/802م) على السلاح".
كما عيّن النفس الزكية ولاةً على أهم الأمصار التي بايعته، ويذكر الطبري بعضها قائلا: "استعمل محمدٌ الحسنَ بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على مكة...، [ثم] استعمل القاسم بن إسحق على اليمن، وموسى بن عبد الله على الشام...، فقُتل [النفسُ الزكية] قبل أن يصلا" إلى أماكن ولايتهما. وأيضا يذكر البلاذري أنه "خرج عثمان بن إبراهيم التيمي إلى اليمامة (= اليوم منطقة الرياض وجوارها بالسعودية) ليأخذها لمحمد فلم يصل إليها حتى بلغه قَتْل محمد".
وصلت أنباء سيطرة النفس الزكية على المدينة -خلال تسعة أيام- إلى البلاط العباسي في العراق، ويلخص ابن الطقطقي تداعيات هذا الحدث العظيم قائلا: "قام المنصور وقعد، وتراخت المدة حتى تكاتبا وتراسلا، فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتابا نادرا معدودا من محاسن الكتب، احتج فيه وذهب في الاحتجاج كلَّ مذهب. وفي آخر الأمر نَدَبَ [المنصورُ] ابنَ أخيه عيسى بن موسى (ت 168هـ/784م) لقتاله (= النفس الزكية)، فتوجه إليه عيسى بن موسى في عسكر كثيف، فالتقوا في موضع قريب من المدينة، فكانت الغلبة لعسكر المنصور، فقُتل محمد بن عبد الله وحُمل رأسه إلى المنصور، وذلك في [منتصف رمضان] سنة خمس وأربعين ومئة".
وبذلك طُويت صفحة مركز الثورة في الحجاز لتتبعها سريعا تصفية جناحها في البصرة وجوارها جنوبي العراق عندما "أخِذ أصحابُ إبراهيم وعمّاله فقُتلوا في البوادي والنواحي"؛ طبقا للبلاذري.
 (المصدر: ميدجيرني)
(المصدر: ميدجيرني)
انتكاسة سريعة
قد يكون من الخطأ تفسير ما آل إليه أمر ثورة النفس الزكية بضعف خبرته العسكرية، أو أنه لم يكن مدركا لطبيعة الميدان الذي وقعت عليه معركته وهو فضاء المدينة النبوية، فهو كان أحد رجالات جيش الإمام زيد حيث تمرس في العمل العسكري، لكن سيادة الروح الثورية المثالية على الروح العسكرية الواقعية عند النفس الزكية ولدى أتباعه هي التي جعلته يتخذ الكثير من القرارات غير المناسبة، فقد تم الضغط عليه من أتباعه برمزيته "المهدوية" التي تم تحميلها أكثر مما تحتمل، ومن ذلك افتراضهم أنه سيكون مؤيَّدا بالنصر بغض النظر عن الأسباب!
والواقع أن النفس الزكية كان مدركا لكل ذلك؛ فعندما فضّل الخروج في المدينة على ما عداها من الحواضن الأخرى كان واعيا بإشكالاتها الإستراتيجية، فالبلاذري يفيدنا بأن النفس الزكية خطب أتباعه في المدينة صبيحة اليوم الذي سيطر عليها فيه، فقال: "يا أهل المدينة! إني والله ما خرجتُ فيكم للتعزُّز بكم، فلَغيرُكم أعزُّ منكم، وما أنتم بأهل قوة ولا شوكة، ولكنكم أهلي وأنصار جَدّي فحبوتكم بنفسي، والله ما من مصرٍ يُعبد اللهُ فيه إلا وقد أخَذتْ لي دعاتي فيه بيعةَ أهلِه"!!
ولم يكن النفس الزكية هو وحده صاحب التقدير لتلك الإشكالات وإنما يبدو أنها كانت حصيلة نقاشات كبار مستشاريه، حتى من العلماء الذين قد يُفترض فيهم أنهم أبعد الناس عن تلك المعياريات الإستراتيجية في خطط الحروب وإدارتها. فالطبري يخبرنا بأن الإمام المحدّث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري "قال: إنا لَعِنْدَ محمد (= النفس الزكية) ليلة... إذْ قال محمد: أشيروا عليّ في الخروج والمقام، قال: فاختلفوا فأقبل عليَّ فقال: أشر علي يا أبا جعفر، قلت: ألستَ تعلم أنك أقلّ بلاد الله فَرَسًا وطعاما وسلاحا وأضعفها رجالا؟ قال: بلى، قلت: تعلم أنك تقاتل أشد بلاد الله رَجُلًا وأكثرها مالا وسلاحا؟ قال: بلى، قلت: فالرأيُ أن تسير بمن معك حتى تأتي مصر، فو الله لا يردُّك رادٌّ، فتقاتل الرجلَ (= المنصور) بمثل سلاحه وكُرَاعه (= خَيْله) ورجاله وماله"!!
كذلك فإنه وفقا لتقديرات الموقف التي قُدّمت إلى المنصور من مستشاريه؛ فقد استبعد بعضهم أن يخرج النفس الزكية من المدينة باعتبارها بلدا "ليس فيه زرع ولا ضرع ولا تجارة واسعة"؛ حسبما جاء في كتاب ‘مسالك الأبصار‘ للعمري الذي يؤكد أن الترجيحات كانت تميل إلى إعلان الثورة من البصرة، إذْ لما سأل المنصور أحد كبار مستشاريه عن ترجيحه لذلك قائلا:
"هل كان عندك من هذا علم؟ قال: لا، ولكني لما ذكرتَ لي خروجَ رجل إذا خرج مثلُه لم يتخلف عنه أحد، ثم ذكرت البلد الذي خرج به (= المدينة) فإذا هو لا يحتمل الجيوش، فعلمت أنه سيطلب غير بلده، ففكرت في مصرَ فوجدتها مضبوطة، وفي الشام والكوفة فوجدتهما كذلك، ثم فكرت في البصرة فوجدتها خالية فخفتُ عليها؛ فقال له المنصور: أحسنت"!!
والغريب أن البصرة كانت فعلا عاصمة الثورة الثانية بقيادة إبراهيم بن عبد الله أخي النفس الزكية، ومثل هذا التقدير لا يخرج بهذا الشكل إلا عن علم مسبق بالقدرة العسكرية للخصم، مما ينفي عن معسكر الثورة السذاجة العسكرية بشهادة خصومهم في مجلس حرب المعسكر العباسي.
إن الفكر العسكري السليم كان يحتم أن يتجنب محمد النفس الزكية المواجهة المباشرة إلى حين توافر القاعدة العسكرية والسياسية المناسبة، وفي حال قرر المواجهة كان عليه أن يحافظ على إستراتيجية الحروب اللانظامية -أو "حرب العصابات"- على غرار ما فعلت تنظيمات الخوارج السابقة عليه والمعاصرة له، حتى يتسنى له وجود دولة مركزية حاضنة مثل مصر أو الشام أو بلاد اليمن التي أوشك النفس الزكية أن ينحاز إليها؛ فالبلاذُري يخبرنا أنه "كان المنصور أمر القواد أن يكاتبوا محمدا ويُطْمِعُوه في أنفسهم، لأنه كان [عازما] على المضيّ إلى اليمن، فلما فعلوا أقام ولم يبرح المدينة"!!
 (المصدر: ميدجيرني)
(المصدر: ميدجيرني)
انضباط مفقود
كذلك يبدو أن تكوينات جيش النفس الزكية لم يحكمها مبدأ الانضباط العسكري، وكان فيهم من يتقن الفكر العسكري ومن لا يحسنه، ويبدو أن هذا الجزء الأخير كان يحاصر قائد الثورة بالمزايدات والشعارات المنفكّة عن البصيرة الحربية اللازمة.
فرغم أن ما دخل فيه النفس الزكية من تدابير الثورة يعدّ أمرا من صميم السياسة العملية وفن الحرب، وهي قضايا اجتهادية تحكمها حسابات المصلحة ومعطيات الميدان المتقلبة؛ فإنه استجاب لأصحاب الصوت الأعلى المزايد على الصوت العسكري ربما خشية من تفرق الكلمة، وقد أثر ذلك على بعض قراراته الحربية الحاسمة التي جنح فيها إلى التأسي بـ"النص" رغم أنها من موارد "الاجتهاد" البحت.
فمثلا عندما جمع النفس الزكية أصحابه "استشارهم في حفر خندق رسول الله ﷺ، فقال له جابر بن أنس (ت بعد 144هـ/762م) رئيس [قبيلة] سُليم: يا أمير المؤمنين نحن أخوالك وجيرانك، وفينا السلاح والكُرَاع (= الخيل)، فلا تُخَنْدِق الخندقَ، فإن رسول الله ﷺ خَنْدَقَ خَنْدَقَهُ لِمَا اللهُ أعلَمُ به، وإنْ خَنْدَقْتَهُ لَمْ يَحْسُنِ الْقِتَالُ رَجَّالَةً (= مشاةً)، ولم تُوَجَّهْ لنا الخَيْلُ بين الأزقة، وإن الذين تُخَنْدِقُ دونهم هم الذين يحول الخندقُ دونهم"؛ طبقا لابن الأثير.
لا شك في أن رأي زعيم قبيلة سُليم كان أصوب عسكريا، ويبدو كذلك أنه صدر ممن هم أكثر الناس إخلاصا لقائد الثورة وأصدقهم التفافا حوله بسبب صلة القرابة حسبما جاء في النص، لكن هذا الرأي واجه معارضة من بعض قادة معسكر الثورة قادها رجل من بني شُجاع من قبيلة جُهَينة، فقد خاطب هذا الرجلُ النفسَ الزكية قائلا: "خَنْدِقْ، [فقد] خَنْدَقَ رسول الله ﷺ فاقتدِ به، وتريد أنت أن تدع أثَرَ رسول الله ﷺ لرأيك! قال: إنه والله يا ابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم، وما شيء أحب إلينا من مناجزتهم (= محاربتهم)"!!
وتعليق النفس الزكية هذا يؤكد أنه يعرف مرامي تلك المزايدة، وأنها ليست أكثر من تهرُّب من القتال والمواجهة، ومع ذلك فقد قال لرجاله:" إنما اتبعنا في الخندق أثرَ رسول الله ﷺ فلا يردني أحد عنه فلست بتاركه! وأمر به فحُفر، وبدأ هو فحَفَر بنفسه [مكان] الخندق الذي حفره رسول الله ﷺ للأحزاب" في غزوة الخندق سنة 5هـ/627م.
لقد كان من الطبيعي ألا تصمد كافة أجنحة هذا التشكيل العسكري غير المنضبط لحظة اشتداد المواجهة مع جيش المنصور بقيادة ابن أخيه المحنّك عيسى بن موسى العباسي (ت 168هـ/784م)، ولذلك يخبرنا ابن الأثير أنه حين حمي وطيس المعركة من حول النفس الزكية سرعان ما "تفرق عنه جُلّ أصحابه حتى بقي في ثلاثمئة رجل يزيدون قليلا، فقال لبعض أصحابه: نحن اليوم بعِدّة أهل بدر"!!
وهكذا فإن الجزء الباقي من المعركة أخذ بعدا فدائيا مثاليا، لا تحكمه قواعد الفكر العسكري في الكَرّ والفَرّ، وإنما تقوده الروح الاستبسالية في الإقدام والتضحية، ويبدو أن النفس الزكية أراد أن يخط لنفسه نهاية كريمة تترك أثرها في مخيلة الأتباع، وكانت تلك النهاية تجسيدا لإحدى وصايا والده عبد الله التي خاطبه بها مع أخيه إبراهيم؛ فقال لهما حسب ابن الأثير: "إنْ منَعَكما أبو جعفر -يعني المنصور- أن تعيشا كريميْن فلا يمنعكما أن تموتا كريميْن"!!
ويبدو أن تلك الوصية لم تبرح ذهن النفس الزكية في ختام المعركة؛ إذْ "كان محمد قد جمع الناس، وأخَذَ عليهم الميثاق، وحَصَرَهم فلا يخرجون [من المدينة]، وخطبهم... فقال لهم: «إن عدوّ الله وعدوّكم قد نزل الأعْوَص (= موضع قرب المدينة)، وإن أحق الناس بالقيام بهذا الأمر لَأبناءُ المهاجرين والأنصار، ألا وإنا قد جمعناكم وأخذنا عليكم الميثاق، وعدوُّكم عددٌ كثير، والنصرُ من الله والأمر بيده، وإنه قد بدا لي أن آذن لكم، فمن أحب منكم أن يُقِيم أقام، ومن أحب أن يظعن (= يرحل) ظَعَن»"!!
وأما النفس الزكية فقد ثبت في الميدان أمام ضغط أعدائه المكثف "وصابرهم... إلى العصر، ثم جعل الناس يتفرقون عنه وهو يقول: يا بني الأحرار إلى أين؟ وقَتل بيده اثني عشر رجلا"؛ وفقا للبلاذري، وأما الطبري فيروي أنه "قَتَل بيده يومئذ سبعين رجلا" من جيش المنصور الذي كان قوامه أربعة آلاف مقاتل، معظمهم من الخراسانيين المخلصين في ولائهم لعرشه!!
لقد ذهب نداء قائد الثورة المستنجد سدى في غبار المعركة؛ إذْ كان من نتيجة خيار الفرار الذي أتاحه لمقاتليه أن رفع الحرج عمن لا قدرة له على الاستبسال في القتال، وبالتالي -كما يقول ابن الأثير- تفلّت أنصار الثورة من ميدان المعركة "فخرج عالَمٌ كثير، وخرج ناس من أهل المدينة بذراريهم وأهليهم إلى الأعراض (= النواحي) والجبال، وبقي محمد في شرذمة يسيرة" حتى قُتل مقْبلا غير مدْبر ومعه عدد غير قليل من أعيان فرسان جنده!!
المصدر : الجزيرة نت