
فتن متجددة
وقد استغل الإمبراطور المغولي تيمورلنك هذه الحروب الأهلية بين الناصر فرج ومعارضيه فقرر احتلال بلاد الشام، ودخلها بادئا بحلب حتى اقتحم دمشق في شعبان 803هـ (يناير/كانون الأول 1401م)، وقد ارتكب فيها إحدى أشد جرائمه وحشية ودموية.
ففي مصنَّفه التاريخي المعروف بـ«تاريخ ابن حَجّي»؛ يخبرنا المؤرخ الشامي المعاصر لتلك الأحداث شهاب الدين ابن حَجّي (ت 816هـ/1414م) بأن تيمورلنك قد "أباح دمشق ونهب ما بقي فيها، وحرقها فهي تنهب، وأطلقت النار في أرجائها، وأسروا من قدروا عليه...، يمر بالجمع الكثير فيأخذ ما أراد من النساء وغير ذلك، فلم يقدر أحدٌ منهم على دفعه مما حصلَ عندهم من الخوف والجبن". وقد سجل المقريزي تفاصيل كارثة تيمورلنك -كما سنرى بعضه بعد قليل- ذاهبا إلى أن آثارها المأساوية كانت من أبرز عوامل انهيار الدولة المملوكية وقرب أفولها.
وأمام هذه الفاجعة الكبرى؛ خاف السلطان والأمراء المماليك على أنفسهم، فانسحب السلطان فرج إلى القاهرة وترك دمشق تواجه مصيرها الأليم، وقد انسحب منها تيمورلنك بعد شهر مخلفا دمارا حضاريا شبيها بما وقع في بغداد قبل ذلك بقرن ونيّف على أيدي أسلافه من التتار، وعاد المماليك سيرتهم الأولى من الحرب والقتال، حتى تمكنوا من خلع فرج وتعيين أخيه عبد العزيز لأشهر قليلة قبل أن يخلعوه.
لم يجد كبار الأمراء المماليك المعارضين له -مثل أمير طرابلس شيخ المحمودي (ت 824هـ/1421م) الذي لم يلبث أن صار سلطانا، فضلا عن أمير الشام نوروز الحافظي (ت 817هـ/1414م)- سوى الاتحاد لمواجهة هذا السلطان السفيه القاتل، فتم قتله وأُلقي لأيام في مزابل دمشق سنة 815هـ/1412م!! ويكفي أن المقريزي -وكانت له به صلة وثيقة- قد ألقى عليه بالمسؤولية عن الرُّزء الذي نزل بالدولة ورعاياها في تلك السنوات العصيبة، وكان دليلا على جهله وتعطشه للدماء وتسببه في خراب الديار.
وعن ذلك يقول في كتابه ‘السلوك لمعرفة دول الملوك‘: "كان الناصر هذا أشأمَ ملوك الإسلام؛ فإنه خرب بسوء تدبيره جميع أراضي مصر وبلاد الشام، من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات، فطرق الطاغية تيمورلنك بلاد الشام في سنة ثلاث وثمانمئة (803هـ/1401م)، وخرب حلب وحماة وبعلبك ودمشق، وحرقها حتى صارت دمشق كوماً ليس بها دار! وقتل من أهل الشام ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وقطع أشجارها حتى لم يبق بدمشق حيوان، ونُقل إليها مِن مصر حتى الكلاب، وخربت أراضي فلسطين بحيث أقامت القدس مدة إذا أُقيمت صلاة الظهر بالمسجد الأقصى لا يصلي خلف الإمام سوى رجلين"!!
ونظرا للحرب الأهلية التي استمرت منذ وفاة السلطان برقوق في سنة 801هـ/1398م وحتى مقتل الناصر فرج في سنة 815هـ/1412م، وما ترتب على هذه الأحداث من اضطراب هائل في منظومة الحكم كما رأينا؛ فقد اتفق أمراء المماليك على الخروج عن تقليد إسناد منصب "السلطنة" إلى أحدهم، وتعيين الخليفة العباسي نفسه في هذا المنصب؛ فيكون بذلك جامعا بين وظيفتيْ "الخلافة" و"السلطنة" لأول مرة في عصر "الخلافة العباسية" بنسختها المملوكية.
وبُعيد مقتل السلطان فرج سنة 815هـ/1412م؛ اتفق الجميع على تعيين خليفة عباسي لقّبوه المستعين بالله الثاني (ت 833هـ/1430م) خروجا من أزمة السلطة. وانقسم الحكم يومذاك بين نائب السلطان في الشام نوروز الحافظي (ت 817هـ/1414م)، وقائد الجيش -الذي هو صاحب السلطة الحقيقية بمصر- شيخ بن عبد الله المحمودي (ت 824هـ/1421م).
وكان الخليفة المستعينُ بين هذين الأميرين كالمحجور عليه عمليا حتى قرر قائد الجيش شيخ المحمودي خلعه من منصب "الخلافة" سنة 815هـ/1412م والحجر عليه رسميا، وإثر ذلك "سيَّرَ [الخليفةَ] المستعينَ إلى الإسكندرية... إلى أن مات بها شهيدًا بالطاعون في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين (833هـ/1430م)"؛ طبقا للإمام السيوطي في ‘تاريخ الخلفاء‘.
وهكذا دخلت الدولة المملوكية في حرب أهلية جديدة جراء صراع شيخ ونوروز على السلطنة، لكنها لم تطُل هذه المرة؛ إذْ سرعان ما قضى شيخ على خصمه في غضون سنة 817هـ/1415م وانفرد بالحكم، لكن واجهتْه مشكلة أخرى تمثّلت في استغلال أمراء التركمان في جنوبي ووسط الأناضول لاضطرابات المماليك وإعلانهم العصيان والاستقلال، وسنرى أن مشكلة الإمارات التركمانية في جنوب ووسط الأناضول كانت -طوال قرن لاحق وحتى سقوط المماليك- من أهم عوامل ضعفهم ثم انهيارهم، بسبب استنزافها لخزانة الدولة المملوكية.
لقد أرسل السلطان المؤيّد شيخ المحمودي ابنه الأمير صارم الدين إبراهيم (ت 823هـ/1420م) مرارا على رأس حملات عسكرية إلى الأناضول لقمع أمير "إمارة دلغادر" (ذو القدر)، التي كانت تعدّ أقوى الإمارات التركية التي قامت على أنقاض الدولة السلجوقية في الأناضول: ناصر الدين محمد بن دلغادر (ت 846هـ/1442م).
ففي سنة 820هـ/1417م؛ حاصر المماليك بقيادة الأمير صارم الدين "أَبُلُسْتَيْن (= البستان: مدينة تركية شمالي محافظة مرعش) وقد فرّ منها ابن دلغادر، وأخلى البلاد من سكانها"؛ وفقا للمؤرخ ابن تَغْري بَرْدي في كتابه ‘النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‘.
وفي سنة 822هـ/1419م بلغت قوات المماليك -بقيادة صارم الدين إبراهيم نجل السلطان- وسط الأناضول، حتى إنها تمكنت من الاستيلاء على مدينة قيصارية/قيسارية "فحضر إليه أكابر البلد من القضاة والمشايخ والصّوفيّة، فتلقّوه فألبسهم الخِلَع (= ثياب تشريفية)، وطلع قلعتها يوم الجمعة، وخطب في جوامعها للسلطان، وضُربت السّكة (= العملة النقدية) باسمه، وأنّ شيخ جلبى (ت بعد 822هـ/1419م) نائب قيسارية تسحّب (= انسحب) منها قبل وصول العساكر إليها، وأن [الأمير صارم الدين] ابنَ السلطان خلع على محمد بك بن قرمان (ت 828هـ/1425م) وأقرّه في نيابة السلطنة بقيسارية، فدقت البشائر بقلعة الجبل (= مقر السلطان بالقاهرة) لذلك، وفرح السلطان بأخذ قيسارية فرحا عظيما؛ فإن هذا شيء لم يتّفق لملك من ملوك التّرك بالديار المصرية سوى الملك الظاهر بيبرس"؛ طبقا لابن تَغْري بَرْدي.
لكننا سنرى أن الصراع المملوكي التركماني في جنوبي ووسط الأناضول تجدد مع معظم السلاطين اللاحقين حتى نهاية دولة المماليك، وقد أدت الدورات المتعاقبة لهذا الصراع إلى استنزاف الخزانة المملوكية، وأصبح -مع عدة عوامل أخرى- من أهم أسباب سقوط دولتهم. 
حروب وراثة
بعد عودته من حملته المظفرة في جنوبي الأناضول؛ سرعان ما توفي الأمير صارم الدين إبراهيم مقتولا بالسم -على أرجح الروايات- في سنة 823هـ/1420م، ثم تبع ذلك موت والده السلطان المؤيد شيخ في السنة التالية 824هـ/1421م، ففتحت تلك التطورات الطريق مجددا على مشكلة تعيين السلطان الجديد.
وهي مشكلة يقودنا أمرها إلى الإلمام بالآثار الخطيرة لظاهرة محاولات توريث السلطة لأبناء السلاطين، سواء بمبادرة من مماليكهم الأمراء أو برغبة من السلاطين أنفسهم، ففي كلتا الحالتين كانت هذه الظاهرة -التي هي نوع خاص من صراعات العرش التي تطرقنا لها سابقا- أحدَ العوامل المؤجِّجة للصراعات البينية على عرش الدولة المملوكية، خاصة بعد أن استفحلت هذه الظاهرة منذ مطلع القرن التاسع الهجري/الـ15م.
لقد أثّرت هذه الظاهرة في البنية السياسية لدولة المماليك فوق الصراعات العصبية المملوكية، ولاسيما عندما تراجع الولاء للدولة لصالح عصبية الولاء الشخصي للسلطان والأمير "السيد" بعد أن صارت "الجنسية (= القومية) علّة الضم (= الولاء)"؛ حسب تعبير الإمام العَيْني الذي حلل هذه الظاهرة العصبية في كتابه ‘عِقد الجمان‘.
فمع كل تولية لأحد أبناء السلاطين كانت تندلع اضطرابات تستمر أشهرا -وربما سنوات- بين رجال السلطان الراحل ورجال نظرائه من القادة الطامحين لتولي السلطة مكانه، وكانت تصاحب تلك الاضطراباتِ موجاتُ قتلٍ وانهيار اقتصادي، على النحو الذي صوره لنا المقريزي بقوله -في كتابه ‘السلوك لمعرفة الملوك‘- متحدثا عن لحظة انطلاق الشائعات بوفاة السلطان المؤيد شيخ المحمودي سنة 824هـ/1421م:
"هذا والناس في القاهرة على تخوُّفِ وقوعِ الفتنة بموت السلطان، وقد كثر عبث المفسدين وقطاع الطريق ببلاد الصعيد، وفَحُش قتْل الأنفس وأخْذ الأموال هناك. ومع ذلك فالأسواق كاسدة والبضائع بأيدي التجار بائرة، والأحوال واقفة، والشكاية قد عمَّت فلا تجد إلا شاكيا وقوفَ حاله وقلة مكسبه، وجور الولاة والحكام وأتباعهم متزايد؛ فنسأل الله حسن العاقبة"!!
وغالبا ما تنتهي تلك الاضطرابات بخلع وسجن خليفة السلطان المنصَّب من بين أبنائه، ثم اعتلاء الأقوى من الأمراء الذي غالبا ما كان قائد الجيش أو من يليه من كبار الأمراء ذوي لقب "أمير مئة مقدّم ألف"؛ ذلك أن المماليك ساروا على درب أسيادهم الأيوبيين فكان لكل سلطان مماليكه الخواصّ الذين أطلقت عليهم المصادر المملوكية "المماليك السُّلطانية"، وهم الجيش الشخصي للسلطان وحرسه الخاص، ولهم نفوذهم وقوتهم في مفاصل الدولة، وقد بلغ عدد مماليك السلطان المؤيد شيخ وحده خمسة آلاف مملوك!
وكان أهم رجال الطبقة الحاكمة العليا هم كبار الأمراء ممن يحملون رُتبة "أمير مئة مقدَّم ألف"؛ حتى إنه كان شائعا في أوساط أجنحة السلطة أنه "ما يصلح للوزارة إلا واحد من مماليك مولانا السلطان يكون ‘أمير مئة مقدم ألف‘"؛ وفقا للمؤرخ ابن أيْبَك الصَّفَدي (ت 764هـ/1363م) في كتابه ‘أعيان العصر وأعوان النصر‘.
فمثلا إثر وفاة السلطان الظاهر برقوق تولى ابنه الناصر فرج السلطة فأفسد البلاد ثم قُتل؛ فجاء مكانه المؤيد شيخ الذي تولى ابنه الصالح محمد فخلعه الظاهر طَطَر/تَتَر (ت 824هـ/1421م)، ثم المظفر أحمد بن الظاهر طَطَر الذي خلعه الأشرف بَرْسْبَاي. ثم جاء العزيز يوسف بن بَرْسْبَاي (ت 868هـ/1463م) الذي وصفه السيوطي -في ‘نظم العِقْيان في أعيان الأعيان‘- بأنه "نظر في فنون العلم والأدب" فخلعه الظاهر أبو سعيد جَقْمَق العلائي (ت 857هـ/1453م).
وإثر وفاة جَقْمَق تولى السلطنة المنصور عثمان (ت 892هـ/1487م) الذي خلعه الأشرف إينال (ت 865هـ/1461م) ليتولى العرش، قبل أن يعهد بالسلطنة إلى ابنه المؤيد شهاب الدين أحمد (ت 893هـ/1488م) الذي خلعه السلطان الظاهر خُشْقَدم (ت 872هـ/1467م) رغم أن المؤيد هذا لما اعتلى العرش "سُرَّ الناسُ بسلطنته قاطبة، وأمِنَتْ السُّبُلُ في أيامه، واطمأن كل أحد على نفسه وماله"؛ وفقا لابن تَغْري بَرْدي في ‘النجوم الزاهرة‘. ثم تولى الحكم -بعد وفاة خُشْقَدم- سلطانان ضعيفان قبل أن يتسلّمه أعظم وأطول سلاطين الجراكسة عمرا، ألا وهو السلطان الأشرف قايْتْباي (ت 901هـ/1495م) الذي ظل في سلطنته 29 سنة وأشهرًا.
وبعد وفاة الأشرف قايْتْباي سنرى انهيارًا سريعا في دولة المماليك؛ ففي غضون خمس سنوات تولى عرشَ الحكم المملوكي ستةُ سلاطين، كل منهم كان شريكا بصورة أو أخرى في قتل من سبقه بمن فيهم السلطان الناصر محمد بن قايْتْباي (ت 904هـ/1498م)، قبل أن يرتقي العرشَ آخرُ سلطانين وهما الأشرف قانْصُوه الغُوري (ت 922هـ/1516م)، ثم ابن أخيه السلطان الأخير للدولة المملوكية الأشرف طُومان باي (ت 923هـ/1517م) الذي أعدمه السلطان العثماني سليم الأول (ت 926هـ/1520م) على باب زُويلة جنوبي القاهرة، لتُطوى بذلك صفحة دولة المماليك.

سلطة تغالب
لقد آثرنا أن نستعرض هذا النمط من التعيين والعزل وسرعة الانقلابات العسكرية في دولة المماليك الجراكسة، لنرى أن هذه الدولة التي استمرت مدة 139 سنة تولى فيها السلطنة خمسة وعشرين سلطانًا، لم يبرز منهم إلا تسعة فقط حكموا مدة 130 سنة، هم: الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج بن برقوق، والمؤيَّد شيخ والأشرف برسباي، والظاهر جَقْمَق والأشرف إينال، والظاهر خُشْقَدم والأشرف قايْتْباي والأشرف قانْصُوه الغُوري.
أما الآخرون -وهم ستة عشر سلطانًا- فلم يحكموا سوى تسع سنوات فقط من عمر الدولة، في تعاقب على السلطة سريع ومريع يبرهن على التردي الأمني والسياسي الذي أصيبت به هذه الدولة في كثير من فترات عُمرها.
حتى إننا نجد المؤرخ جمال الدين بن تَغْري بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- يضع لسنة 824هـ/1421م عنوانا مستقلا في تاريخه جاء فيه: "السنة التي حكم فيها أربعة سلاطين: وهي سنة أربع وعشرين وثمانمئة (824هـ/1421م)؛ حكم في أوّلها إلى يوم الاثنين ثامن المحرّم الملك المؤيدّ شيخ، ثم ابنه الملك المظفّر أحمد إلى تاسع عشرين شعبان، ثمّ الملك الظاهر طَطَر إلى رابع ذي الحجة، ثمّ ابنه الملك الصالح محمد إلى آخرها وإلى شهر ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين وثمانمئة (825هـ/1422م)".
ولئن كانت ظاهرة تولية الأطفال من أبناء السلاطين الراحلين عرشَ السلطنة قد عرفتها الدولة المملوكية الأولى، كما مرَّ معنا في قصة تعيين الطفل كُجُك ابن الناصر قلاوون سلطانا، وهو مثال واحد من أمثلة عدة تشمل إخوتَه وغيرَه؛ فإن هذه أخذت وتيرة متكررة في الدولة المملوكية الثانية، بحيث صارت شبه تقليد لازم عند موت أي سلطان سواء تم ذلك بأن يَعهد بالسلطنة لأحد أبنائه الصغار من بعده، أو بأن تتعصَّب المماليك السلطانية لابن سلطانهم المتوفّى فيولونه في مكانه حفاظا على مصالحهم ونفوذهم.
فقد اتفق رجال نخبة "المماليك السُّلطانية" على سلطنة المظفر أحمد بن المؤيَّد شيخ (ت 833هـ/1430م) بعد وفاة والده السلطان، وكان طفلا بالغ الصغر؛ حتى إن رواية المؤرخ المملوكي ابن شاهين المَلَطي الظاهري (ت 920هـ/1514م) -في ‘نيل الأمل في ذيل الدول‘- تكشفُ أنه لما جاء الأمراء إلى هذا الطفل الصغير ليُجلسوه على "سرير الملك" أو كرسي السلطنة كان يبكي لكونه طفلا لا يعقل ما يُراد منه! وعند مبايعته سلطانا "أجلِس المظفّر أحمد والأمراء حوله، وقد أقيمت الخدمة بالقصر، فلما انقضت الخدمة أُعيد إلى أمّه"!!
وقاد استمرار هذه الظاهرة -معظم القرن التاسع الهجري/الـ15م- إلى اشتعال الصراع بين كبار أمراء الدولة والجيش، وكان عددهم يبلغ في العادة ما بين 18 و24 أميرا كبيرا مقدَّما، وغالبا ما كان أقواهم "أتابك العسكر" أو قائد الجيش، ثم "أمير سلاح" (قائد الأسلحة)، وأمير مجلس (مدير تشريفات البلاط)، والدَّوَادار (سكرتير السلطان)، وأمثالهم.
وفي حالة الطفل المظفر ابن السلطان المؤيد شيخ؛ شكّل قادة الأمراء مجلسًا للوصاية يتولى تسيير شؤون السلطنة، لكن هذا المجلس شهد صراعا بين ثلاثة من كبار الأمراء، سرعان ما أنهاه لصالحه الأميرُ طَطَر/تَتَر (ت 824هـ/1421م) فتسلطن وتلقب بـ"الظاهر"، إلا أنه لم يهنأ بالسلطنة إلا أربعة وتسعين يومًا فقط، لكنه "في هذه المدة اليسيرة لا تستقلّ ما فعله من الانتقام والجور وسفك الدماء، فأتعبَ نفسه، ومهّدَ لغيره"؛ حسب ابن تَغْري بَرْدي في ‘المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي‘.
وقد وقَع طَطَر فيما وقع فيه السلاطين السابقون؛ فأوصى قُبيل وفاته بالسلطنة لولده الصغير: الصالح ناصر الدين محمد بن طَطَر (ت 833هـ/1430م)، وقد أُجبِر على تشكيل مجلس وصاية يُسيّر شؤون السلطنة فيه كل من: الأمير جانبك الصوفي (ت 841هـ/1437م) قائد الجيش ومدبّر الدولة، والأمير بَرْسْباي الدُّقْماقي (ت 841هـ/1437م) الذي كان حينها كاتبا للسلطان ثم صار سلطانا بعدها بقليل، والأمير طَرَباي/طَرَاباي (ت بعد 824هـ/1421م) الذي كان "حاجب الحُجّاب" أي مدير ديوان السلطان، وكان يعدّ نفسه "من يوم مات الملك الظاهر برقوق متميّزا على بَرْسْبَاي، ويرى أنه هو الأكبر والأعظم في النّفوس"؛ طبقا لابن تَغْري بَرْدي في ‘النجم الزاهرة‘.
وسرعان ما انخرط هذا الثلاثي في صراع دموي على العرش كعادة من سبقهم من السلاطين، حتى قضى برسباي -بمساعدة عظيمة من طَرَباي- على جانْبَك الصوفي حين اعتقله، أما طَرَباي فقد أوقعه بَرْسْبَاي في فخ في القلعة انتهى بمقتله، وذلك بعد أن استدعاه بحجة التشاور في أمر عاجل متعلق بمسألة دولة تركمان "قره قويونلو" (ذوو الخِراف السود) الشيعية.
ويصف لنا الإمام ابن حجر العسقلاني -في ‘إنباء الغمر بأنباء العُمر‘- اللحظات الأخيرة من حياة الأمير طرباي؛ فيقول: "قال بَرْسْبَاي لطَرَباي: أنتم ما تعرفون أني كبير الأمراء؟! قال: نعم، قال: فلمَ تخالفون أمري؟ وأشار بالقبض على طرباي، فقام فجذب السيف فحمى نفسه، فهجم عليه قَصْرُوه (= قَصْرُوه من تمراز الظاهري المتوفى 838هـ/1434م) أمير آخور (= أمير الإسطبلات) فناوشه، فضربه برسباي من خلفه فجرح يده فسقط منها السيف فأمسِك، وأمسِك معه أميران من جهته، وأرسِلوا إلى الإسكندرية فاعتُقلوا بها".
ولم تمرّ سوى أسابيع قليلة على هذه الحادثة -التي وقعت في ربيع الأول سنة 825هـ/1422م- حتى ارتقى الأشرف بَرْسْبَاي إلى سلطنة المماليك في الشهر التالي على انقلابه الدموي هذا، بعدما قضى على خصومه؛ لتبدأ سلطنته التي استمرت حتى نهاية سنة 841هـ/1437م.

نقطة تحوُّل
لقد جمعت سلطنة الأشرف بَرْسْبَاي عدة متناقضات فكانت أفضل مما سبقها في أمور وأسوأ منها في أخرى، لكنها شكلت محطة فارقة على منحنى انحدار الدولة المملوكية الذي ظل يتعمق حتى لحظة سقوطها النهائي؛ وهو ما يستلزم التطرقَ لعهده ببعض التفاصيل كشفا لأهم الجذور البعيدة لذلك السقوط المدوي.
فقد كان من أبرز الإنجازات العسكرية للأشرف برسباي أنه "فُتحت في أيامه عدة فتوحات، وجهز العساكر إلى أخذ قبرس (قبرص) في سنة ثمان وعشرين (828هـ/1425م)"؛ كما في ‘المنهل الصافي‘ لابن تَغْري بَرْدي. ولئن نجح برسباي في الاستيلاء -الذي سبق الإلمام ببعض تفاصيله- على جزيرة قبرص التي أصبحت تابعة سياسيا للمماليك في القاهرة حتى سقوط دولتهم؛ فقد واجه تحديات أخرى عملت على خلخلة الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وأول هذه التحديات الكبيرة كان هروب "أتابك العساكر" (قائد الجيش) السابق الأمير جانبك الصوفي -وهو العدو اللدود للسلطان برسباي- من سجنه إلى إمارة عائلة دلغادر (ذو القدر) التركمانية في جنوب وسط الأناضول، حيث احتضنوه ودعموه طوال اثنتي عشرة سنة.
والتحدي الثاني هو ظهور التنافس العسكري والسياسي لدولة قبيلة "قره قويونلو" (ذوو الخِراف السود) وهي دولة تركمانية شيعية، نشأت في شرق الأناضول وأجزاء من العراق وشمال إيران وجنوب القوقاز بُعيد الانسحاب المغولي التيموري من المنطقة، وقد مثّلت تهديدا لدولة المماليك في هذه الفترة لاسيما في مناطق ديار بكر وآمِد الواقعتين اليوم في جنوب شرقي تركيا.
وقد أرسل برسباي عدة حملات عسكرية لتأديب حكام كل من "إمارة دلغادر" (ذو القدر) ودولة قبيلة "آق قويونلو" (ذوو الخِراف البِيض) التركمانية في جنوبي الأناضول، حتى إنه خرج بنفسه في سنة 836هـ/1432م لحصار آمد بهدف القضاء على الأمير عثمان بن قرايلك (ت 839هـ/1435م) المؤسس الحقيقي لهذه الإمارة، وقد استمر حصاره هذا خمسة وثلاثين يوما، واختلفت عساكره عليه.
ويمدنا ابن تَغْري بَرْدي -في ‘النجوم الزاهرة‘- برواية مفصّلة عن حصار برسباي لآمد -الذي يبدو أنه كان ضمن من رافقوا السلطان فيه- وندمِه على الخروج من القاهرة، رغم أن حملته هذه على ابن قرايلك لم تنتهِ حتى "تم وانتظم الصلح بينهما على أن قرايلك يقبّل الأرض للسلطان، ويخطب باسمه في بلاده، ويضرب السكة على الدينار والدرهم باسمه".
ورغم النجاح الظاهري لهذه الحملة العسكرية المملوكية المتمثل في إقرار الأمير قرايلك بالتبعية لسلطان المماليك؛ فإن المؤرخ المملوكي داود بن علي الصيرفي (ت 900هـ/1494م) يقدم -في ‘نزهة النفوس والأبدان في حوادث الزمان‘- تقييما لها في غاية السلبية، فيخبرنا بأنه:
"عُدّتْ هذه السفرة من أشنع ما يكون لزيادة ضررها وعدم نفعها، ولما أتلفه السلطان من المال بسببها، حتى إن المال النقد الذي أُنفق فيها من الخزائن الشريفة مبلغه خمسمئة ألف دينار (= اليوم 100 مليون دولار أميركي تقريبا)، وتلف له من الخيل والسلاح والجمال وغير ذلك ما يكون نظير المال المذكور، وتلف للأمراء والعساكر بمصر والشام ما يبلغ قيمته مئات قناطير من الذهب"!! وهذه التكاليف المذكورة جميعها تقدّر اليوم بما يناهز ملياريْ دولار، وهو مبلغ كبير للغاية لاسيما بمقاييس ذلك العصر، وقد أثر بلا شك على الأوضاع الاقتصادية للبلاد فيما بعد.
ولكن الأخطر من ذلك ما شهده العصر الشركسي -وخاصة في أيام برسباي- من انحلال للانضباط العسكري، الذي طالما ميز الشخصية العسكرية المملوكية ومنحها النصر الحاسم في معاركها الفاصلة؛ فضاعف سلبيات ضعف تكوين هذه الشخصية الذي تولد عن اختلال المنهجية الصارمة في تأهيلها العسكري والثقافي والأخلاقي، كما سبق وصفه.
وقد تجلى انحلال الانضباط العسكري المملوكي في ظاهرةِ مخالفةِ بعض أكابر الأمراء للسلاطين في القضايا المفصلية الكبرى، ولاسيما خلال الحملات العسكرية التي تستلزم انضباطا كاملا وصرامة لا تلين، ولعل تراتبية الجيش المملوكي -التي قامت على العصبيات العرقية ثم الولاء الشخصي للسلاطين- هي التي أدت إلى هذه الاضطرابات المتوالية.
فكبار أمراء ومماليك السلاطين السابقين كانوا يُعرَفون بـ"القرانيص" أي: المحاربون القدماء، وأمراء ومماليك السلاطين المتأخرين (سلاطين القرن التاسع الهجري/الـ15م وما بعده) كان يُطلق عليهم "الأجلاب" و"المماليك السلطانية"، ومماليك الأمراء كانوا يسمون بـ"السيفية".
و"القرانيص" كانوا ينقسمون بحسب السلاطين الذين يتبعون لهم؛ فـ"الظاهرية" هم مماليك السلطان الظاهر برقوق، و"الناصرية" هم مماليك ابنه الناصر فرج، و"المؤيّدية" هم مماليك السلطان المؤيد شيخ، و"الأشرفية" هم مماليك الأشرف برسباي، وقد كان الانتماء إلى الزمالة والعصبية -فوق الدولة وأمنها واستقرارها- هو السبب في هذا الانهيار الأمني الداخلي.
ولئن حاول برسباي الحفاظ على مكانته وسلطنته من خلال المبالغة في حماية مماليكه "الأجلاب" -أو "المشتروات" كما كانوا يسمَّون- وهم الحرس السلطاني الخاص وقلب الجيش المملوكي، وأقوى وحداته تسليحا ومكانة؛ فإن سياسة التدليل تلك كانت لها عواقبها الوخيمة في عصره فضلا عن العصور التي تلته.
لقد رأينا -فيما نقلناه سابقا عن المقريزي- ضعف تأهيل المماليك العسكري والتربوي منذ عصر السلطان الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة، ولهذا السبب كثيرا ما ثار هؤلاء الأجلاب على كبار رجال الدولة وتعدَّوْا عليهم دون رادع.
فابن تَغْري بَرْدي يخبرنا -في ‘النجوم الزاهرة‘- أنه في ربيع الأول من سنة 838هـ/1434م "ثارت مماليك السلطان الأجلاب، سكّان الطّباق (= الثكنات العسكرية) بقلعة الجبل، وطلبوا القبض على مُباشري الدولة (= كبار موظفي الإدارة كالوزير ومدير المالية) بسبب تأخر جوامكهم (= رواتبهم الشهرية)، ففرّ المباشرون منهم ونزلوا إلى بيوتهم، فنزل في أثرهم جمع كبير منهم"، ونهبوا بيوت هؤلاء الموظفين، وأغلِقت الأسواق في القاهرة خوفا من فسادهم!
ويعلق ابن تَغْري بَرْدي على هذه الحادثة قائلا: "والعجب أن السلطان [برسباي] لم يغضب لعبد الباسط [بن خليل الدمشقي (ت 854هـ/1450م) ناظر الجيش (= قائد الأركان)] بل انحرف عليه، وأمر بنفيه إلى الإسكندرية لكسر الشر، ولم يقع منه في حق مماليكه المذكورين أمر من الأمور، إما لمحبته فيهم، أو لبغضه في عبد الباسط".
ولقد أدى تعاقب هؤلاء السلاطين جميعا ومن يليهم -حتى سقوط دولة المماليك- إلى نشوب صراع لم يفتر على الزعامة والمكانة في بنية الدولة المملوكية، وقد حرص السلاطين على حماية مماليكهم "الأجلاب" عند الغزو والغارة، وهي الحماية التي كانت تثير حنق المماليك الآخرين لاسيما "القرانيص" و"السيفية" وباقي "أجناد الحلقة" (الجيش المملوكي النظامي).
ومن الأمثلة على تلك الحماية وتبعاتها السلبية ما حصل في حصار آمد حين خاطب برسباي قادة جيشه قائلا: "يكون الذي يركب مع الأمراء للزحف المماليكُ القرانيص، وأنا ومماليكي الأجلابُ نكون خلفهم. وقامت قيامة القوم، وتنكّرت القلوب على السلطان في الباطن" بسبب هذا الموقف؛ كما يذكر ابن تَغْري بَرْدي في ‘النجوم الزاهرة‘.
وقد ازداد خطر دولة الآق قويونلو في جنوب شرق الأناضول على ممتلكات ومدن المماليك في تلك المناطق، ولاسيما ملطية ومرعش وكختا وكركر وغيرها، واضطر برسباي إلى تجريد الحملات العسكرية تلو الأخرى، حتى خرجت الحملة الأخيرة في مرض وفاته سنة 841هـ/1437م، وقد اشتد عليه المرض فمات بعدما أعدَم طبيبيْن له قتلا بالسيف لعجزهما عن علاجه، وهذا ينمّ عن جهله وعاميته؛ حسب المؤرخ شهاب الدين ابن عربشاه الدمشقي (ت 854هـ/1450م) في ‘التأليف الطاهر في سيرة الملك الظاهر جَقْمَق‘.
بل إنه ظهرت بجوار دولة "آق قويونلو" (ذوو الخِراف البِيض) دولةُ بني عمومتهم "قره قويونلو" (ذوو الخِراف السود) الشيعية، والتي نشأت -بزعامة قرا يوسف التركماني (ت 823هـ/1420م)- عقب سقوط الإيلخانيين والتيموريين في العراق وأذربيجان وشرق الأناضول.
وبالتدريج شكّلت هذه الدولة الشيعية خطرا وجوديا على المماليك أشدَّ من دولة "آق قويونلو" (ذوو الخِراف البِيض) السنية؛ فقد راح ولاتُها في شرق الأناضول والعراق يتعدون على العباد والبلاد بالمظالم المتنوعة، حتى حكم فقهاء دولة المماليك بكفرهم وضرورة قتالهم، وقد رأى ابن تَغْري بَرْدي "بدر الدين حسن البُرْدِينى (ت 831هـ/1428م) أحد نوّاب الحُكم (= نائب قاضي القُضاة) الشافعية، وهو راكب على بغلته [في شوارع القاهرة] وبيده ورقة يقرأ منها استنفار الناس لقتال قرا يوسف، وتعداد قبائحه ومساوئه"!!
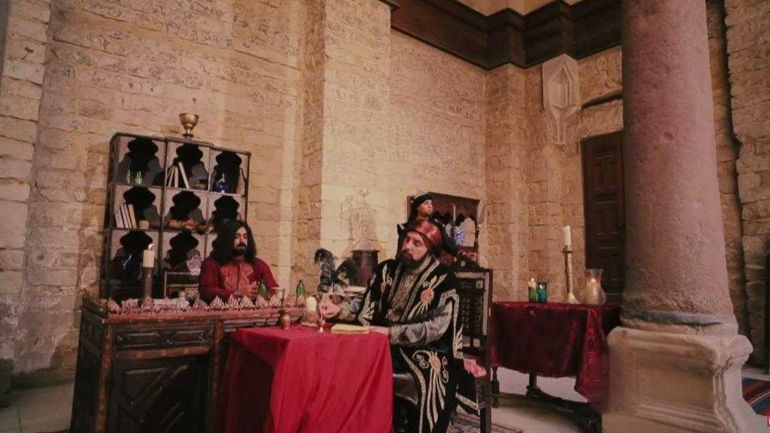
اختلال إداري
ألقت أزمة الاضطراب السياسي والصراعات الدامية على عرش الدولة المملوكية الثانية (784-923هـ/1382-1517م) بظلالها على مؤسسات الدولة المدنية الحيوية، فتفشّت فيها عوامل الاختلال الإداري الذي عصف بما كانت عليه من كفاءة وفعالية في عهد الازدهار، وكان من أخطر أمارات هذا الاختلال ذلك التهميش الذي نال منصب الوزارة، والذي يبدو أنه كان ثمرة منطقية للتخلي عن المنهج التكويني المعياري للمماليك أنفسهم الذين هم عماد السلطة بأكملها تأسيسا وتسييرا.
وقد بلغ ذلك التهميش مستوى جعل المؤرخ ابن تَغْري بَرْدي يأمل أن يزول منصب "الوزارة" (رئاسة الوزراء) من مؤسسات الدولة، لما آل إليه أمره من ضعف وضياع؛ فهو يرى -في ‘النجوم الزاهرة‘- أنه "لو مَنّ الله سبحانه وتعالى بأن يَبطُل اسم «الوزير» من الديار المصرية في هذا الزمان.. لكان ذلك أجود وأجمل بالدولة..، لأن.. [هذه الوظيفة].. تنازلت [عنها] ملوك مصر في أواخر القرن الثامن [الهجري/الـ14م] حتى وليها في أيامهم أوباشُ الناس وأسافلُ الكَتَبَة..، وذهبـ[ـت] بهم أبّهة هذه الوظيفة الجليلة التي لم يكن في الإسلام -بعد الخلافة- أجلُّ منها ولا أعظمُ"!!
ويبدو أن أمله الساخر هذا لم يتحقق بدليل ما سجله -في آخر حياته- من أن الوزارة هي "أرفع الوظائف قدرا في سائر بلاد الله، وفي كل قطر من الأقطار إلا الديار المصرية فإنه انحط بها قدرها، ووليها من الأوباش وصغار الكتبة جماعة من أوائل القرن التاسع [الهجري/الـ15م] إلى يومنا هذا"!!
ثم يذكر ابن تَغْري بَرْدي وقائع تعيين خمسة رؤساء وزراء، صدر قرار تولية أحدهم في أوائل سنة 868هـ/1463م رغم أنه "كان أحد الأعوام الأوباش الأطراف السوقة"، ولذلك كان صفر اليدين من الخبرة الإدارية التي تؤهله لهذا المنصب العظيم لأنه "لم يتقدم له نوع من أنواع الرئاسة، ومع هذه المساوئ باشر بظلم وعَسْف، وعدم حشمة وقلة أدب مع الأكابر والأعيان، وساءت سيرته وكثر الدعاء عليه إلى أن أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، وأراح الله المسلمين منه؛ وقد هجاه الشعراء بأهاجٍ كثيرة"!!
ويبدو أن تهميش منصب الوزارة كان نتيجة طبيعية للإهمال الإداري الذي شهدته الدولة المملوكية -في القرن السابق- على مستوى منصب السلطنة نفسها، ولاحظه عدد من العلماء قدّموا كُتُبا تضمنت مشاريع إصلاحية للدولة المملوكية، كان من بينهم الإمام تاج الدين السبكي الذي عايش نهاية الدولة المملوكية الأولى، وسجل بوضوح -في كتابه ‘مُعيد النعم ومُبيد النقم‘- ذلك الإهمال الإداري قائلا إن من مظاهر جحود نعمة رئاسة المسلمين أن يظن السلطان أن الولاية هي أن يكون "آكلا شاربا مستريحا"، وهو إنما تولى أمر المسلمين "لينصر الدين ويُعلي الكلمة"!
وكان من آثار ذلك الإهمال اختلال سلم الأولويات وفقا للسبكي؛ فقد انتقد أن "يفرِّق [السلطان] الإقطاعات على مماليك اصطفاها وزينها بأنواع الملابس، والزراكش المحرمة، وافتخر بركوبها بين يديه، ويترك الذين ينفعون الإسلام جياعا في بيوتهم"!! كما انتقد أن "يفرق [السلطان] الإقطاعات على مماليك اصطفاها وزينها بأنواع الملابس، والزراكش المحرمة، وافتخر بركوبها بين يديه، ويترك الذين ينفعون الإسلام جياعا في بيوتهم"!!
ورفض السبكي بشدة سلوك البذخ في بناء المساجد الكبرى وهو إحدى سمات العصر المملوكي، خصوصا تلك التي كانت تشيَّد بعائدات الضرائب الظالمة ونهب أموال الرعية، فنجده يخاطب الحاكم بقوله: "تريد أن تعمر الجوامع بأموال الرعايا، ليقال: هذا جامع فلان؟! فلا والله لن يتقبله الله تعالى أبدا، وإن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا"!!
وفي حقبة لاحقة من الدولة المملوكية؛ تحدث المؤرخ المصري ابن إياس -في كتابه ‘بدائع الزهور‘- عن ذلك السلوك الجائر، وموقف العلماء من بعض المساجد التي بُنيت بأموال الشعب المغتصبة من أجل التدليس على الناس، وقال إن المصريين "اللطفاء" أطلقوا على مدرسة/مسجد بناه السلطان قانْصُوه الغوري بأموال الضرائب الظالمة اسم "المسجد الحرام"!!
ووصل الإهمال أيضا إلى مرافقة حيوية مثل مؤسسة الحِسبة، حتى إنه -منذ مطلع القرن التاسع الهجري/الـ15م- انحسم موقع الحسبة في الدولة المملوكية لتغدو وظيفة يتولاها الجند والمماليك بعد أن كانت إحدى "الوظائف الدينية" المركزية التي لا يتولاها إلا كبار الفقهاء والقضاة، فتحولت بذلك إلى وضعية صارت بها أقرب إلى الوظيفة الأمنية والبلدية.
وأول أمير مملوكي تولى إدارة مؤسسة الحسبة هو منكلي بُغا العجمي (ت 836هـ/1413م)، وكان ذلك سنة 816هـ/1413م؛ حسب المَلَطي في ‘نيل الأمل‘. ويفيدنا ابن حجر العسقلاني -في كتابه ‘إنباء الغُمْر بأنباء العُمر‘- بأن منكلي بغا "يقال إنه أول من أضيفت له وظيفة الحسبة من التُّرْك (= المماليك)"! أما الإمام جلال الدين السيوطي فقد جزم بذلك -في كتابه ‘تاريخ الخلفاء‘- فقال إن منكلي بغا "أول من ولي الحسبة من الأتراك في الدنيا"!!
ويتحدث المقريزي -في ‘السلوك‘- واصفا تفشي الفساد في مؤسستيْ الحسبة والقضاء، وهو الخبير بدهاليزهما؛ فيقول إنه كان "كلُّ ما يكسبه الباعة -مما تغش به البضائع وما تغبن فيه الناس في البيع- يجبى منهم بضرائب مقررة لمحتسبيْ القاهرة ومصر وأعوانهما، فيصرفون ما يصير إليهم من هذا السُّحْت في ملاذهم المنهي عنها، ويؤديان منه ما استداناه من المال الذي دُفع رشوة عند ولاياتهما، ويؤخران منه باقيه لمهاداة أتباع السلطان ليكونوا عونا لهما في بقائهما!
وأما القضاة (= قضاة القضاة للمذاهب الفقهية الأربعة) فإن نوابهم يبلغ عددهم نحو المئتين، ما منهم إلا من لا يحتشم من أخذ الرشوة على الحكم، مع ما يأتون -هم وكُتّابهم وأعوانهم- من المنكرات بما لم يُسمع بمثله فيما سلف، وينفقون ما يجمعونه من ذلك فيما تهوى أنفسهم، ولا يغرم أحد منهم شيئا للسلطنة بل يتوفر عليهم، فهم يَتخوَّلون (= يتصرفون) في مال الله تعالى بغير حق ويحسبون أنهم على شيء، بل يصرحون بأنهم أهل الله وخاصته افتراءً على الله سبحانه"!!
ولعل من مظاهر تدهور مؤسسة القضاء في العصر المملوكي المتأخر ما ذكره القلقشندي من أن لقب «القاضي» فَقَدَ دلالته الأصلية في المعجم الوظيفي؛ فقال إن "كُتّاب الزمان يُطلقون هذا اللقب -والألقاب المتفرّعة منه كالقضائيّ والقاضويّ- على «أرباب الأقلام» في الجملة، سواء كان صاحب اللّقب متصدّيا لهذه الوظيفة أو غيرها، كسائر العلماء والكتّاب ومن في معناهم، وعلى ذلك عُرْفُ العامّة أيضا"!!
ويمكن القول إن الفساد الإداري كان سمة لازمة للدولة المملوكية البرجية منذ نشأتها، إذا اعتمدنا الحكم الذي قدمه المقريزي -في ‘السلوك‘- بقوله إنه منذ أحكم الأمير برقوق خيوط نفوذه في دواليب الدولة تدهورت معايير اعتبار الأمانة والكفاءة في كبار الموظفين، وصارت "الولايات كلها من القضاء والحسبة وولاية الحرب -في الأعمال والكشف وسائر الوظائف- لا سبيل أن ينالها أحد إلا بمال يقوم به أو بأدائه، ويكتب به خطَّه؛ فتطاول كل نذل رذل وسفلة إلى ما سنح بخاطره عن الأعمال الجليلة والرتب العلية، فدُهِي الناسُ من ذلك بِداهيةٍ دَهْياءَ أوجبت خراب مصر والشام"!!
ويحلل المقريزي -في ‘إغاثة الأمة‘- مآلات الاختلال المعياري في إجراءات التعيين الإداري في عهد برقوق، وتأثير ذلك على الأوضاع الأمنية وفعالية الإدارة العامة في البلاد؛ فيقول: "وانسحب الأمر في ولاية الأعمال بالرشوة إلى أن مات الظاهر برقوق، فحدث لموته اختلاف بين أهل الدول إلى تنازع وحروب...؛ فاقتضى الحال -من أجل ذلك- ثورة أهل الريف وانتشار الزعَّار (= عصابات اللصوص) وقُطّاع الطريق، فخِيفتْ السبل، وتعذر الوصول إلى البلاد إلا بركوب الخطر العظيم، وتزايدت غباوة أهل الدولة، وأعرضوا عن مصالح العباد، وانهمكوا في اللذات"!!
يتبع...